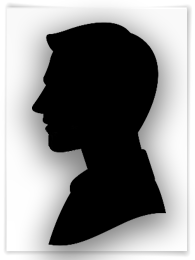القدوري
القدوري أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي. ولد ومات في بغداد. انتهت اليه رئاسة الحنفية في العراق، وصنف المختصر المعروف باسمه (القدوري - ط) في فقه الحنفية. ومن كتبه (التجريد) في سبعة أجزاء يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وكتاب (النكاح - ط).
دار العلم للملايين - بيروت-ط 15( 2002) , ج: 1- ص: 212
القدوري أحمد بن محمد.
دار القلم - دمشق-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 363
القدوري الحنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي المعروف بالقدوري، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق وكان حسن العبارة في النظم، وسمع الحديث وروى عنه الخطيب في تاريخه وصنف في مذهبه ’’المختصر’’ المشهور وغيره، وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفراييني الشافعي، وتوفي سنة ثمان وعشرين وأربع مائة ببغداذ، ومن شعره..
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 7- ص: 0
القدوري الحنفي أحمد بن محمد.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 24- ص: 0
القدوري شيخ الحنفية، أبو الحسين؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، البغدادي القدوري.
قال الخطيب: كتبت عنه، وكان صدوقا، انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية، وعظم وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة، جريء اللسان، مديما للتلاوة.
قلت روى عن: عبيد الله بن محمد الحوشبي، ومحمد بن علي بن سويد المؤدب.
روى عنه: الخطيب، والقاضي أبو عبد الله الدامغاني.
مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربع مائة وله ست وستون سنة.
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 13- ص: 224
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، الإمام المشهور أبو الحسين بن أبي بكر، الفقيه، البغدادي. المعرةف بالقدوري صاحب ’’ المختصر ’’ المبارك.
تكرر ذكره في ’’ الهداية ’’ و ’’ الخخلاصة ’’، وغيرهما.
مولده سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.
أخذ الفقه عن أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وهو أخذ عن أبي بكر الرازي. عن أبي الحسن الكرخي، عن أبي سعيد البردعي، عن أبي علي الدقاق، عن أبي سهل موسى ابن نصر الرازي، عن محمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.
وتفقه على القدوري أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد وشرح ’’ مختصره ’’.
وتفقه غيره عليه ممن لا يحصى.
وروى الحديث عن محمد بن علي بن سويد المؤدب، وعبيد الله بن محمد الحوشبي.
وروى عنه قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني، والخطيب.
وقال: كتبت عنه، وكان صدوقا، ولم يحدث إلا بشيء يسير.
وكان ممن أنجب في الفقه، لذكائه.
انتهت إليه بالرعاق رياسة أصحاب أبي حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه.
وكان حسن العبارة في النظر، جرى اللسان، مديما لتلاوة القرآن.
وقال السمعاني: كان فقيها، صدوقا.
صنف من الكتب ’’ المختصر ’’ المشهور، فنفع الله تعالى به خلقا لا يحصون، وشرح ’’ مختصر الكرجي ’’ و ’’ التجريد ’’ في سبعة أسفار، يشتمل على مسائل الخلاف بين أصحابنا وبين الشافعي، شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة، وله ’’ التقريب ’’ في مجلد، و ’’ مختصر ’’ جمعه لابنه، وغير ذلك من التصانيف.
وذكره أبو محمد الفامي، في ’’ طبقات الفقهاء ’’، وأثنى عليه.
وقال: كان له ابن فلم يعلمه الفقه، وكان يقول: دعوه يعيش لروحه.
قال: فمات وهو شاب.
ومات القدوري في يوم الأحد، الخامس عشر من شهر رجب، سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، ودفن من يومه في داره بدرب أبي خلف.
نقله الخطيب والسمعاني، وحكاه جماعة، منهم ابن خلكان.
وزاد: ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور، ودفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي.
وخرج له في ’’ الجواهر المضيئة ’’ حديثا واحدا، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
مناظرة بين
أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي استدل أبو الحسين في المختلعة أنه يلحقها الطلاق، بأنها معتدة من طلاق، فجأز أن يلحقها ما بقي من عدة الطلاق، كالرجعية.
فكلمه أبو الطيب الطبري، وأورد عليه فصلين:
أحدهما، أنه قال: لا تأثير لقولك: إنها معتدة من طلاق، لأن الزوجة ليست بمعتدة، ويلحقها الطلاق، فإذا كانت المعتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء، ثبت أن قولك: المعتدة، لا تأثير له، ولا يتعلق الحكم به، ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة، كتعليقه على كونه مظاهرا منها، وموليا عنها، ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة، كان حال العدة وما قبلها سواء، ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدل على تعليق الحكم به.
وأما الفصل الثاني؛ فإن في الأصل أنها زوجة، والذي يدل عليه أنه يستبيح وطئها من غير (عقد جديد)، فجائر أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق، وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة، على أنه لا يستبيح وطئها من غير عقد جديد، فهي كالمطلقة قبل الدخول.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين: أنه قال: لا يخلو القاضي، أيده الله تعالى، في هذا الفصل، من أحد أمرين؛ إما أن يكون مطالبا بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها، (فأنا ألتزم بذلك، وأذل بصحته، ولكنه محتاج ألا يخرج المطالبة بتصحيح العلة، والدلالة على صحتها) مخرج المعترض عليها بعدمالتأثير، أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير، فإن كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم، لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلة لم تعم جميع المواضيع التي يثبت فيها الطلاق، وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلة، وهذا لا يجوز أن يكون قادحا في العلة، مفسدا لها. يبين صحة هذا، أن علة الربا التي تضرب بها الأمثال في الأصول والفروع، لا تعم جميع المعلومات، لأنا نجعل العلة في الأعيان الأربعة؛ الكيل مع الجنس، ثم يثبت الربا في الأثمان، مع عدم هذه العلة، ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علة الربا معنى واحد.
فإن قلتم: لا تعم جميع المعلومات، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجبا لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم، أن نعلل الأعيان الستة بعلتين، يوجد الحكم مع كل واحدة منها، ومع عدمها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه العلل لا تعم جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة، وجب أن يكون في مسألتنا مثله.
وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذي نجيب به عن السؤال الذي ذكره، وأيضا، فإني أدل على صحة العلة.
فالذي يدل على صحتها أننا اجتمعنا على أن الأصول كلها معللة بعلل، وقد اتفقنا على أن الأصل الذي هو الرجعة معلل أيضا، غير أنا اختلفنا في عينها، فقلتم أنتم: إن العلة فيها بقاء الزوجية: وقلنا نحن: العلة وجود العدة من طلاق. ومعلوم أننا إذا عللناه بما ذكرتم من الزوجية لم يبعد، وإن عللناه بما ذكرته من العدة تعدت إلى المختلعة، فيجب أن تكون العلة هي المتعدية دون الأخرى.
وأما معارضتك في الأصل، فهي علة مدعاة، وتحتاج أن يدل على صحتها، كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي.
وأما منع الفرع فلا نسلم أنها زوجة؛ فإن الطلاق وضع لحل العقد، وما وضع للحل إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا في فسخ سائر العقود.
فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف، والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع، (وأن الحكم تابع له، غير أني كشفت عن طريق الشرع) له، وقلت: إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه العلة، ويثبت مع عدمها، لم يكن ذلك علة في الظاهر، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع، فحينئذ يجوز أن يعلق الحكم عليه، ومتى لم يدل الدليل على ذلك، وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع عدمه، وليس معه ما يدل على صحة اعتباره، دل على أنه ليس بعلة.
وما ذكره الشيخ الجليل من علة الربا، وقوله: إنها إحدى العلل. فليس كذلك، بل هي وغيرها من معاني الأصول سواء، فلا معنى لهذا الكلام، هو حجة عليك، وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل، وادعت كل طائفة معنى، طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه، ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى، فكان يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك؛ لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه، فكما وجب الدلالة على صحة علة الربا وجب أن يدل أيضا على صحة علة الرجعية.
وأما جريان الربا مع الأثمان، مع عدم علة الأربعة، فعلة أخرى، تثبت بالدليل، وهي علة الأثمان.
وأما في مسألتنا، فلم يثبت كون العدة علة في وقوع الطلاق، فلم يصح تعليق الحكم عليها.
وأما الفصل الثاني فلا يصح، وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة، وهي دعوى تحتاج أن يدل عليها، وأنا لا أسأله؛ لأن الأصل المعلل عندي ما دل عليه الدليل.
وأما كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، على الفصل الثاني، فإن طالبني بتصحيح العلة فأنا أدل على صحتها.
والدليل على ذلك، أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت زوجة له، فطلقها، وقع عليه الطلاق. فلو طلقها قبل الدخول طلقة ثم طلقها، لم يلحقها؛ لأنها خرجت عن الزوجية، فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها، لحقها طلقة، فدل (على أن العلة فيها) ما ذكرت، وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.
وأما إنكاره لمعنى الفروع، فلا يصح لوجهين: أحدهما، أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة، ولا يزيل الملك، فهذا لا يتعلق به تحريم الوطء، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ويحل له وطؤها.
والثاني، أني أبطل هذا عليه، بأنه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلا بنكاح، ولما أجمعنا أنه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دل على أن العقد باق، وأن الزوجية ثابتة.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: أما قولك إني مطالب بالدلالة على صحة العلة. فلا يصح، والجمع بين المطالبة بصحة العلة، وعدم التأثير تناقض، وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعا بكونها مؤثرة، فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها، ولا المطالبة، أو مقطوعا بأنها غير مؤثرة، فلا يجوز المطالبة فيها أيضا بالدلالة على صحتها؛ لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرة، فلا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له في المعاني، وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المؤثرة في الحكم، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا لا تأثير له، ولكن دل على صحته لو كانت العلة مشكوكا في كونها مؤثرة في الحكم لم يجز القطع على أنها غير مؤثرة، وقد قطع القاضي بأن هذه العلة غير مؤثرة، فبان بهذه الجملة، أنه لا يجوز أن يعترض عليها من جهة عدم التأثير، ويحكم بفسادها، ليتنبه، ثم يطالبني مع هذا بتصحيحها؛ لأن ذلك طلب محال جدا.
وأما ما ذكرت من علة الربا، فهو استشهاد صحيح، وما ذكر من ذلك حجة علي؛ لأن كل من ادعى علة في الربا) دل على صحتها، فيجب أن يكون هاهنا مثله. فلا يلزم؛ لأني أمتنع من الدلالة على صحة العلة، بل أقول: إن كل علة ادعاها المسئول في مسألة من مسائل الخلاف، فطولب بالدلالة على صحتها لزمه إقامة الدليل عليها، وإنما امتنع أن يجعل الطريق المسئول لها وجود الحكم مع عدمه، (وأنه لا يعم) جميع المواضع التي بين فيها ذلم الحكم، وهو أبقاه الله تعالى، جعل المفسد لهذه العلة وجود نفوذ الطلاق مع عدم العلة، وذلك غير جائز، كما قلنا في علة الربا في الأعيان الأربعة، إنها تفقد ويبقى الحكم.
وأما إذا طالبتني بتصحيح العلة، واقتصرت على ذلك، فإني أدل عليها، كما أدل على صحة العلة التي ادعيتها في مسألة الربا.
وأما الفصل الثاني، وهو الدلالة على صحة العلة، فإن القاضي، أيده الله، تعلق من كلامي بطرفه، ولم يتعرض لمقصوده، وذلك أني قلت: إن الأصول كلها معللة، وإن هذا الأصل معلل بالإجماع بيني وبينه، وإنما الاختلاف في غير العلة، فيجب أن يكون ما ذكرناه هو العلة؛ لأنها تتعدى، فترك الكلام على هذا كله، وأخذ يتكلم في أن من الأصول ما لا يعلل، وأنه لا خلاف فيه، وهذا لا يصح؛ لأنه لا خلاف أن الأصول كلها [معللة]، وإن كان في هذا خلاف فأنا أدل عليه.
والدليل عليه، هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة، وذلك كقوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار)، وكقوله صلى الله عليه وسلم، ’’ إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر ’’.
وعلى أني خرجت من عهده بأن قلت: إن الأصل الذي تنازغنا عليه يعلل بالإجماع، فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأصول.
وأما المعارضة؛ فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ذلك النكاح، ووجود الزوجية؛ يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون، ولا ينفذ طلاقهما، فثبت أن ذلك ليس بعلة، وإنما العلة ملك إيقاع الطلاق، مع وجود محل موقعه، وهذا المعنى موجود في المختلعة، فيجب أن يلحقا.
وأما معنى الفرع، فلا أسلمه.
وأما ما ذكرت من إباحة الوطء، فلا يصح؛ لأنه يطؤها وهي زوجة، لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة، فصادفها الوطء وهي زوجة.
وأما أن يبيح وطئها، وهي خارج عن الزوجية، فلا.
وأما قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرا، فصار في يد البائع خمرا، ثم تخلل: إن البيع يعود بعد ما ارتفع. وعلى أصلكم، إذا رهن عصيرا فصار خمرا، ارتفع الرهن، فإذا تخلل عاد الرهن، وكذلك هاهنا مثله.
فتكلم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول، بأن قال: ليس في الجمع بين المططالبة بالدليل على صحة العلة، وبين عدم التأثير مناقضة؛ وذلك أني إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلة، ومع عدمها، على وجه واحد، كان الظاهر أن هذا ليس بعلة للحكم، إلا أن يظهر دليل على أنه علة، فنصير إليه.
وهذا كما تقول في القياس: إنه دليل على الأحكام، إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر، يجب المصير إليه، إلا أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجب تركه؛ من نص قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.
كذلك ها هنا، الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك، ليس بعلة، إلا أن تقيم دليلا على صحته، فنصير إليه.
وأما علة الربا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت، وقد تكلمت بما يغني عن إعادته.
وأما الفصل الثاني، فقد تكلمت على (ما سمعت)، من كلام الشيخ الجليل، أيده الله تعالى، وهو أنه قال: الأصول كلها معللة.
وأما هذه الزيادة (فالآن سمعتها)، وأنا أتكلم على الجميع.
وأما دليلك على أن الأصول كلها معللة، فلا يصح؛ لأن الظواهر التي وردت في جواب القياس كلها حجة عليك، لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دل عليه الدليل فهو حجة يجب الحكم بها، وذلك لا يقتضي أن كل أصل معلل.
وأما قولك: إن هذا الأصل مجمع على تعليله، وقد اتفقنا على أن العلة فيه أحدى المغنيين؛ أما المعنى الذي ذكرته، (وإما المعنى الذي ذكرته)، وأحدهما يتعدى، والآخر لا يتعدى، فيجب أن تكون العلة فيها ما يتعدى. فلا يصح؛ لأن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي في الدلالة على صحة العلة، وأن الحكم تعلق بهذا المعنى؛ لأن اجتماعنا ليس بحجة، لأنه يجوز الخطأ علينا، وإنما تقوم الحجة بما يقع عليه اتفاق الأمة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعصمتها.
وأما قولك: إن علتي متعدية. فلا تصح، لأن التعدي إنما يذكر لترجيح إحدى العلتين على الأخرى، وفي ذلك نظر عندي أيضا، وأما أن يستدل بالتعدي على صحة العلة فلا، ولهذا لم نحتج نحن وإياكم على مالك في علة الربا، فإن علتنا تتعدى إلى ما لا تتعدى علته، ولا ذكر أحد في تصحيح علة الربا ذلك، فلا يجوز الاستدلال.
وأما فضل المعارضة، فإن العلة في الأصل ما ذكرت.
وأما الصبي والمجنون، فلا يلزمان؛ لأن التعليل واقع، لكونهما محلا لوقوع الطلاق، ويجوز أن يلحقهما الطلاق، وليس التعليل للوجوب، فيلزم عليه المجنون والصبي.
وهذا كما يقال: إن القتل علة إيجاب القصاص، ثم نحن نعلم أن الصبي لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ، وامتناع استيفائه من الصبي والمجنون لا يدل على أن القتل ليس بعلة لإيجاب القصاص.
كذلك ها هنا، يجب أن تكون العلة في الرجعية كونها زوجة، وإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبي؛ لأن هذا إن لزمني على اعتبار الزوجية، لزمك على اعتبار الاعتداد؛ لأنك جعلت العلة في وقوع الطلاق كونها معتدة، وهذا المعنى موجود في حق الصبي والمجنون، فلا ينفذ طلاقهما، ثم لا يدل ذلك أن ذلك ليس بعلة، وكل جواب له عن الصبي والمجنون في اعتباره العدة فهو جوابنا في اعتبار الزوجية.
وأما علة الفرع، فصحيحة أيضا، وإنكارك لها لا يصح، لما ثبت أن من أصلك أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد، والذي يدل عليه جواز وطء الزوجية، وما زعمت من أن الرجعية تصح منه بالمباشرة غلط؛ لأنه لا يبتدئ بمباشرتها وهي أجنبية، فكان يجب أن يكون ذلك محرما، ويكون تحريمه تحريم الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ’’ العينان تزنيان، واليدان تزنيان، ويصدق ذلك الفرج ’’، ولما قلتم: إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها. دل على أنها باقية على الزوجية.
وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم أن العقود كلها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد.
يبين صحة هذا البيع والإجارات، والصلح، والشركة، والمضاربات، وسائر العقود، فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه، من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها، لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذة عن الأصول.
وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني، وقد فرقت بين إزالة النجاسة والوضوء، بأن إزالة النجاسة طريقها التروك، والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك، وألزمني على ذلك الصوم، فقلت له: غالب التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت، فإذا اشتد منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول، ووجب رد المختلف فيه إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها، لأنه أقوى في الظن.
وعلى أن من أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ في الرهن، بل هو موقوف مراعى، فعلى هذا لا أسلمه، ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول، والملك لا يرتفع.
فتكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلة وعدم التأثير، غير جائز.
وأما ما ذكرت، من أن هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول في القياس، وخبر الواحد، فلا يصح، وذلك أنا لا نقول: إن كل قياس دليل وحجة، فإذا حصل القياس في بعض المواضع يعارضه إجماع لم نقل إن ذلك قياس صحيح، بل نقول: هو قياس باطل، وكذلك لا نقول: إن ذلك الخبر حجة ودليل.
فأما القاضي، أيده الله تعالى، فقد قطع في هذا الموضع، بأن هذا لا تأثير له، فلا يصح مطالبته بالدليل على صحة العلة.
وأما الفصل الآخر، وهو الدلالة على أن الأصول معللة فقد أعاد فيه ما ذكره أولا، من ورود الظواهر، ولم يرد عليه شيئا يحكى.
وأما قولك: إن إجماعي وإياه ليس بحجة، فإني لم أذكره لأني جعلته حجة، وإنما ذكرته اتفاقيا، لقطع المنازعة.
وأما فصل التعدي فصحيح، وذلك أني ذكرت في الأصل علة متعدية، ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون علة، وعارضني، أيده الله تعالى، بعلة غي متعدية، وعندي أن الواقعة ليست بعلة، وعنده أن المتعدية أولى من الواقعة، فلا يجوز أن يعارضني بها، وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.
وأما المعارضة فإن قولك: إن التعليل للجواز، كما قلنا في القصاص. فلا يصح؛ لأنه إذا كان علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح، وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت، وجب إيقاع طلاقه، فإذا لم يقع دل على أن ذلك ليس بعلة.
وأما القصاص فلا يلزم؛ لأن هناك لما ثبت له القصاص، وكان العقل هو العلة في وجوده (جاز أن يستوفى له القصاص).
وأما قوله: إن هذا يلزم على علتي. فليس كذلك، لأني قلت: معتدة من طلاق، ’’ فلا يتصور أن يطلق الصبي، فتكون امرأته معتدة من طلاق ’’.
فألزمه القاضي، المجنون إذا طلق امرأته.
انتهت المناظرة، نقلا من ’’ طبقات الشافعية الكبرى ’’ لابن السبكي، من نسخة تحتاج إلى التصحيح.
والله أعلم.
دار الرفاعي - الرياض-ط 0( 1983) , ج: 1- ص: 127
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين القدوري، الحنفي.
سمع عبيد الله بن محمد الحوشبي.
قال الخطيب: لم يحدث إلا بشيء يسير، كتبت عنه، وكان صدوقاً، وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه، وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظم جرئ اللسان، مديماً لتلاوة القرآن.
مولده سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، ومات سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.
مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن-ط 1( 2011) , ج: 1- ص: 1