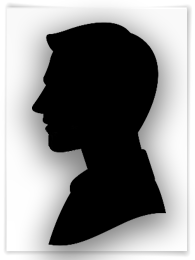أبو عبادة البحتري الشاعر
أبو عبادة البحتري الشاعر اسمه الوليد بن عبيد.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 371
أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي البحتري ولد بمنبج سنة 206 ومات سنة 284.
قال الآمدي في الموازنة: كان يكنى أبا عبادة ولما دخل العراق تكنى أبا الحسن ليزيل العنجهية والأعرابية ويساوي في مذاهبه أهل الحاضرة ويقرب بهذه الكنية إلى أهل النباهة والكتاب من الشيعة، وقد ذكر بعضهم أنه كان يكنى أبا الحسن وأنه لما اتصل بالمتوكل وعرف مذهبه عدل إلى أبي عبادة والأول أثبت.
وقال اليافعي: كان البحتري أمير شعراء عصره ورئيس فصحاء دهره وشعره يقال له سلسلة الذهب وهو في الطبقة العليا، ولد بمنبج ونشأ بها ورحل إلى بغداد ومدح خلفاء وقته ووزراء عصره وأمراء زمانه كما هو ظاهر في ديوانه وأقام بالعراق مدة طويلة ثم عرج إلى الشام واجتمع مع أبي تمام بحمص في أول أمره قبل شهرته ومعروفيته، واستفاد منه وكتب في إكرامه إلى أهل معرة النعمان فأكرموه وأعطوه أربعة آلاف درهم وهي أول إنعاشه.
تشيعه
قال عبد الجليل الرازي أستاذ ابن شهراشوب المازندراني: البحتري من شعراء الشيعة وكان خصيصا بدعبل الخزاعي ومن أصدقائه كما في كتاب اكتفاء القنوع وغيره، ذكر ذلك في ترجمة البحتري. وخلوص دعبل في التشيع مشهور وإكرام أبي تمام للبحتري أيضا كذلك. ويظهر من الشيخ أبي عبد الله أحمد بن عياش في كتابه مقتضب الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر أن البحتري وأبي الغوث الطهوي كانا في عصر واحد، وكانا من الشيعة الاثني عشرية، لكن البحتري يمدح الملوك وأبي الغوث يمدح آل الرسول، وذكر قصيدة لأبي الغوث في مدح الأئمة من آل محمد الاثني عشر، قال كان البحتري أبو عبادة ينشدها وتلك القصيدة ألا يمكن أن ينشدها إلا من كان من الإمامية لأن من جملتها قوله:
ينابيع علم الله أطواد دينه | فهل من نفاد أن عملت لأطواد |
نجوم متى نجم خبا مثله بدا | فصلى عل الخابي المهيمن والبادي |
عباد لمولاهم موالي عباده | شهود عليهم يوم حشر وإشهاد |
هم حجج الله اثنتي عشرة متى | عددت فثاني عشرهم خلف الهادي |
بميلاده الأنباء جاءت شهيرة | فأعظم بمولود وأكرم بميلاد |
وللبحتري في هجو علي بن الجهم نديم المتوكل أبيات يعنفه على نصبه مذكورة في ديوانه المطبوع بالجوائب وغيره وما حركه على ذلك إلا التشيع منها قوله:
إذا ذكرت قريش للمعالي | فلا في العير أنت ولا النفير |
وما رعثانك الجهم بن بدر | من الأقمار ثم ولا البدور |
لأية حالة تهجو عليا | بما لفقت من كذب وزور |
يا سوأة من رأيك العازب | وعقلك المستهتر الذاهب |
أنحيت كي تنفقها زاريا | على علي بن أبي طالب |
قد آن أن يبرد معناكم | لولا لجاج القدر الغالب |
ومما يمكن أن يستدل به على تشيعه قوله في المنتصر وقد أحسن إلى العلويين ووصلهم على عكس أبيه من قصيدة:
رددت المظالم واسترجعت | يداك الحقوق لمن قد قهر |
وآل أبي طالب بعدما | أذيع بسربهم فاندعر |
ونالت أدانيهم جفوة | تكاد السماء لها تنفطر |
وصلت شوابك أرحامهم | وقد أوشك الحبل أن ينبتر |
فقربت من حظهم ما نأى | وصفيت من شربهم ما كدر |
وأين بكم عنهم واللقا | ء لا عن ثناء ولا عن عفر |
قرابتكم بل أشقاؤكم | وإخوتكم دون هذا البشر |
ومن هم وأنتم يدا نصرة | وحدا حسام قديم الأثر |
يشاد بتقديمكم في الكتاب | وتتلى فضائلكم في السور |
وإن عليا لأولى بكم | وأزكى يدا عندكم من عمر |
وكل له فضله والحجول | يوم التفاضل دون الغرر |
كنا نكفر من أمية عصبة | طلبوا الخلافة فجرة وفسوقا |
ونقول تيما قربت وعديها | أمرا بعيدا حيث كان سحيقا |
ونلوم طلحة والزبير كليهما | ونعنف الصديق والفاروقا |
وهم قريش الأبطحين إذا انتموا | طابوا أصولا فيهم وعروقا |
حتى انبرت جشم بني بكر تبتغي | أرث النبي وتدعيه حقوقا |
شاعريته
قال الأستاذ رئيف خوري: إذا جاز فك العناصر التي لا بد منها لتتميم قوام الشعر، فإننا نجد - على الأقل - أربعة من هذه العناصر: الصورة والعاطفة والفكرة والجرس الموسيقي. وقد يغلب، بل كثيرا ما يغلب أحد هذه العناصر على شعر شاعر فإذا جاءت الغلبة للصورة كان الشاعر وصافا، وإذا جاءت للعاطفة كان شاعر حس. وإذا جاءت للفكرة كان شاعر تأمل وجهد عقلي. وإذا جاءت للجرس الموسيقي كان شاعر نغم وإيقاع.
وليس ثمة جدال في أن عنصر الجرس الموسيقي هو عنصر جد ضروري للشعر. بل لعله أهم عناصر الشعر الفارقة ولا سيما ما كان شعرا غنائيا. وبرهان ذلك أننا قد نجد من النثر ما لا يقل حظه من الصورة والعاطفة والفكر عن حظ الشعر. لكنه يبقى أدنى إلى النثر لأنه فاقد الوزن والقافية وهما رأس الوسائل التي بها يتوسل الشعر إلى الموسيقى. ولولا ما يجلبان للشعر من جرس موسيقي رقيق أو فخم رائع لما كان من سبب لأن يقيد بهما الشاعر نفسه.
فإذا صح ما قدمناه وهو على الجملة صحيح لاجتماع أكثر الآراء عليه. ثم إذا نظرنا في ضوء ما قدمناه إلى الحكم الذي أطلقه ابن الأثير على البحتري. رأينا النقادة الشهير يحبس ميزة البحتري في خاصيتين قرن إحداهما بالأخرى.
أولا: أن أبا عبادة أحسن سبك اللفظ على المعنى، أي: توافقت عباراته ومعانيه، وثانيا: أنه أراد أن يشعر فغنى، أي: غلب عنصر الجرس الموسيقي في شعره على كل عنصر آخر في الشعر من صور وعاطفة وفكرة.
فهل أصاب ابن الأثير في حكمه هذا على شاعرنا البحتري؟.
أما أن البحتري أحسن سبك اللفظ على المعنى فأمر لا سبيل إلى الشك فيه. نستطيع أن نلمس ذلك ونتحراه في الألفاظ المفردة التي ينتقيها أبو عبادة، وفي الجمل التي يصوغها من ألفاظه، ثم في صور التعبير التي تدور في كلامه.
وأهم صفة تتحلى بها ألفاظ البحتري المفردة أنها فصيحة مأنوسة في الفهم، عذبة سائغة في السمع والنطق، منزهة عن الابتذال، مبرأة من الغلظة والوحشية، وتلك صفة تشيع في ألفاظه حتى في الطور الأول من حياته حين كان بمنبج وجوارها يعيش عيشة أقرب إلى البداوة وخشونة الذوق البدوي. في هذا الطور من حياته وصف أبو عبادة الذئب وقتاله معه فكان قمينا في مثل هذا الموقف أن يستعمل من الألفاظ أعوصها وأجفاها، ولكنه لم يفعل.
قال مثلا يصور ضعف الذئب وهزاله:
له ذنب مثل الرشاء يجره | ومتن كمتن القوس أعوج منأد |
طواه الطوى ثم استمر مريره | فما فيه إلا العظم والروح والجلد |
ولقد قويت هذه الصفة في ألفاظ البحتري في الطور الثاني من حياته حين انتقل إلى ضفاف دجلة، فاحتك بمتارف الحضارة ومباهج الطبيعة في العاصمتين العباسيتين: بغداد وسامراء. فازدادت ألفاظه أنسا في الفهم وانسياغا في السمع والنطق وتنزها عن الابتذال وتبرءا من الغالظة والوحشية. بل طبعت ألفاظه بطابع جديد لم يكن لها من قبل، هو طابع الأناقة والصقل والرونق.
وحسبنا هذه الأبيات له في وصف الربيع:
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا | من الحسن حتى كاد أن يتكلما |
وقد نبه النوروز في غلس الدجى | أوائل ورد كن بالأمس نوما |
يفتقها برد الندى فكأنه | يبث حديثا كان أمس مكتما |
تنصب فيها وفود الماء معجلة | كالخيل خارجة من حبل مجريها |
كأنما الفضة البيضاء سائلة | من السبائك تجري في مجاريها |
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها | وريق الغيث أحيانا يباكيها |
إذا النجوم تراءت في جوانبها | ليلا حسبت سماء ركبت فيها فأعجب لحسن الاختيار في قوله ’’الربيع الطلق’’ و’’يفتقها برد الندى’’ و’’تنصب فيها وفود الماء’’ و’’ريق الغيث’’، بل انظر في هذه الأبيات كلها هل يمكن استبدال لفظ منها بلفظ أظهر أناقة وأنعم صقلا وأبهى رونقا. |
ومن هذا الوجه أيضا نلقى البحتري صائغا متقنا. فهو لا يقتصر على مراعاة النسب بين ألفاظه لكي ينفي التنافر والثقل عن تركيب جمله، بل يتعدى ذلك إلى مراعاة النسب بين تلك الجمل والمعاني التي يختصها بالقصد.
وأبرز الصفات التي تتحلى بها جمل البحتري من حيث صلتها بالمعنى أنها واضحة مشرقة قلما يكلفك فهمها كدا أو عناء. ومرد ذلك إلى أن أبا عبادة يقصر جمله ولا يحشوها بالمعترضات ولا يسرف في حذف أو تقديم أو تأخير، وإنما يذكر كل ما يرى ذكره يزيد في وضوح العبارة، ويجعل كل قسم من أقسام الجملة في موقعه المألوف، فالفعل في حيث يجب أن يكون الفعل، والفاعل بعد الفعل، وكذلك المبتدأ والخبر على ترتيبهما المعتاد الخ...... حتى جاء في كتاب يتيمة الدهر للثعالبي:
’’إن شعر البحتري كتابة معقودة بالقوافي’’ والمراد بذلك أن البحتري قد ملك ناصية النظم بقدر لو شئنا معه أن نحل شعره من قيد الوزن والقافية فنجعله نثرا لما وجدنا سبيلا إلى تحويل الكلام عن صورته الأولى بحذف قسم من أقسام الجملة أو تقديمه أو تأخيره. وإليك مثلا قوله في وصف الخريف:
لاحت تباشير الخريف وأعرضت | قطع الغمام وشارفت أن تهطلا |
فالخيل تصهل والفوارس تدعي | والبيض تلمع والأسنة تزهر |
تواضع من مجدله وتكرم | وكل عظيم لا يحب التعظما |
وإن حرص البحتري على هذا الوضوح والصفاء والتأنق في سبكه اللفظ على المعنى، لماثل أيضا في اجتنابه صور التعبير الغامضة أو البعيدة. فتراه قريب التشابيه صريح الكنايات داني الاستعارات، ولا يعسف عسفا في طلب المجاز أو البديع شأن أبي تمام مثلا في الكثير من مواقفه.
فأسمع أبا عبادة يصف لك منظر جبال لبنان من دمشق:
تلفت من عليا دمشق ودوننا | للبنان هضب كالغمام المعلق |
وأسمعه في المقطع الذي وصف به قتاله مع الذئب يكني عن قلب الذئب هذه الكناية اللطيفة التي لا يحتاج في فهمها إلى مشقة ولا أعنات:
فاتبعتها أخرى فأضللت نصلها | بحيث يكون اللب والرعب والحقد |
وقد نبه النوروز في غلس الدجى | أوائل ورد كن بالأمس نوما |
كان الصبا توفي نذورا إذا انبرت | نراوحه أذيالها وتباكره |
ولكن ابن الأثير قرن هذه الخاصية في البحتري بخاصية أخرى هي أنه أراد أن يشعر فغنى. بل الأصح أن نقول أن النقادة الشهير إنما أثبت الخاصية الأولى عند البحتري كالتمهيد لخاصيته الثانية وهي أن أبا عبادة شاعر أجمل ما في شعره عنصر الجرس الموسيقي. فهل نرى ابن الأثير أنصف أبا عبادة في حكمه هذا حين جعل بالنتيجة مدار الجمال في شعره على النغم والإيقاع، فقال إنه أراد أن يشعر فغنى، ثم أعاد الكرة فقال: هو على الحقيقة قبة الشعراء في الإطراب.
الواقع أننا حين نطلب الفكرة في شعر البحتري لا نلبث أن نجد حظه منها عاديا مألوفا. فليس في معانيه غوصات تأمل وجهد عقلي كالتي نجدها عند الشعراء المثقفين كأبي نواس وأبي تمام وابن الرومي والمتنبي وسبب ذلك أن البحتري - وهو البدوي النشأة - لم يتوفر له قسط كبير من الثقافة إلا فيما يتصل بآلة اللغة. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن واسع المطامح, وقد وفق من طريق شعر إلى حياة خاصة أبعد ما تكون عن الحرمان حتى قال فيه ابن رشيق: فاض كسبه من شعره، وكان يركب في موكب من عبيد. وهذا الضيق في مطامحه، وما صادف من التوفيق في حياته الخاصة، ما كانا ليثيراه إلى غوص وإلى عمق تحليل. ثم لا شك في أن الجو الذي أحدثه المتوكل باضطهاد المعتزلة، والدعوة إلى ترك المناقشة والتفلسف، قد كان له أثره فيما نلمسه من سطحية البحتري في أكثر معانيه. ودليلنا على ذلك أنه شاء في آخر حياته أن – يتفلسف - فقال في رثائه لأحد أصدقائه:
ولم أر كالدنيا حليلة وامق | محب متى تحسن بعينيه تطلق |
تراها عيانا وهي صنعة واحد | فتحسبها صنعي حكيم وأخرق |
وإذا لم يكن للبحتري استعدادا يخوله أن يكون شاعر فكرة، ولا كان المناخ العقلي في عصره وبيئته ليصرف رجلا مثله إلى سبر الأغوار والتفتيش عن المعاني، فيتعرض لغضب السلطان أو سخط العوام.
فأما الصورة فقد كان نصيب أبي عبادة منها قيما نفيسا. فهو معدود في الشعراء الواصفين وله إجادات مرموقة في وصف الآثار العمرانية والمشاهد الطبيعية، من مثل السينية التي وقف بها على أطلال إيوان كسرى في المدائن، واللامية في القصر الكامل الذي بناه الخليفة المعتز. واليائية الهائية في بركة المتوكل. والميمية في الربيع. ومع هذا يجب الاعتراف بأن أوصافه جلها حسي يتعلق بظاهر الموصوفات، وجلها إجمال قليل الحظ من الدقة في تصوير الملامح وتحريها.
غير إننا حين نلتفت شطر العاطفة عند البحتري توشك أن ترتد إلى مثل ضؤولة نصيبه من الفكرة إلا في بعض قصائد كالتي رثي بها المتوكل غب مصرعه بأيدي الجند الأتراك، فإن فيها من صدق اللوعة والجسارة على قتلة المتوكل وعلى ولي عهده ما يجعلها رائعة من روائع الرثاء، وحجة للبحتري - رغم تذبذبه - على أنه كان قمينا بجمال الوفاء.
وهكذا ترانا إذا استثنينا حظ البحتري من إجادة الصورة، وعرفنا له بعض لمحات دالة على قوة العاطفة، نجد أن حكم ابن الأثير كان صحيحا حين جعل أجمل ما في شعر أبي عبادة عنصر الجرس الموسيقي. فهو العنصر الذي يمتاز به البحتري حقا، وأكبر الظن أن البحتري كان مدركا لشعره ميزته العليا هذه، فكان يباهي الناس مباهاة في إنشاده لعلمه أن الإنشاد يسبغ على شعره عذوبة وطلاوة، ويجد له رونقا يضيع إذا قرأ قصيدة قراءة صامتة.
ولنضرب لنا مثلا. قال البحتري يتغزل بعلوة القينة الحلبية التي عرفها في صباه ثم اتخذها عروسا لشعره يذكرها في مطالع الغزل التقليدي التي يمهد بها للمدح:
عذيري فيك من لاح إذا ما | شكوت الحب حرقني ملاما |
فلا وأبيك ما ضيعت عهدا | ولا قارفت في حبيك ذاما |
ألام على هواك وليس عدلا | إذا أحببت مثلك إن ألاما |
لقد حرمت من وصلي حلالا | وقد حللت من هجري حراما |
أعيدي في نظرة مستثيب | توخى الأجر أو كره الأثاما |
ترى كبدا محرقة وعينا | مؤرقة وقلبا مستهاما |
فمن أين إذن، كان ذلك الوقع الحلو الذي نحسه في أنفسنا حين نردد هذه الأبيات. أنه ناشئ ولا ريب من رشاقتها وحسن رنتها، أي: الجرس الموسيقي العذب الذي احتواه نظم هذه الأبيات وجلاه لنا إنشادها.
وللبحتري صفة خاصة دقيقة، يعالج بها الجرس الموسيقي ويلينه ويطوعه لشعره. فهو بالدرجة الأولى شديد الحرس على اللفظ المأنوس الأنيق وعلى التركيب الشفاف المشرق وعلى صور التعبير القريبة المتناول، مما أدخلناه في حسن سبكه للفظ على المعنى وظاهر أن أنس اللفظ وأناقته ووضوح التركيب وإشراقه، وقرب متناول الصور التعبيرية، كل ذلك خادم لحسن الجرس الموسيقي إذ لا يفسد هذا الجرس شيء كالتعقيد والتقعير، فتشتغل النفس عندئذ بطلب المعنى عند التلذذ برخامة النغم والإيقاع.
غير أن أبا عبادة لا يقتصر على هذا القدر من الصنعة في تطويع الجرس الموسيقي لنظمه بل تراه بارعا مرهف الحس في اجتناب كل نشاز بين حرف وآخر في اللفظة الواحدة، أو بين لفظة وأخرى في التركيب، فهو لا يراعي نسب الألفاظ فيما بينها فقط ولا النسب فيما بين الألفاظ والمعنى فقط، بل يراعي النسب أيضا بين مخارج الحروف وأصواتها ومقاطع الكلمات وأصدائها:
ألام على هواك وليس عدلا | إذا أحببت مثلك أن ألاما |
وإلى ذلك يستعمل البحتري فنا من التسجيع في داخل البيت يكسب نظمه موسيقى مطربة كما في قوله:
ترى كبدا محرقة وعينا | مؤرقة وقلبا مستهاما |
إني وإن جانبت بعض بطالتي | وتوهم الواشون أني مقصر |
ليشوقني سحر العيون المجتلى | ويشوقني ورد الخدود الأحمر |
من مليح يهوي بعامل رمح | ومشيح من السنان بترس |
ومع التسجيع يعتمد البحتري كثيرا على جودة التقطيع للكلام في النظم. وإليك مثلا قوله في البائية التي وصف فيها مصارعة الفتح بن خاقان وزير المتوكل للأسد. قال:
هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب | من القوم يغشى باسل الوجد أغلبا |
فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا | وأقدم لما لم يجد عنك مهربا |
فلم يغنه إن كر نحوك مقبلا | ولم ينجه إن حاد عنك منكبا |
حملت عليه السيف لا عزمك انثنى | ولا يدك ارتدت ولا حده نبا |
هزبر مشى يبغي هزبرا،
وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه غلبا
فأحجم،
لما لم يجدفيك مطمعا
وأ قدم،
لما لم يجد عنك مهربا.
فلم يغنه.
إن كر نحوك مقبلا،
ولم ينجه
إن حاد عنك منكبا!
حملت عليه السيف
لا عزمك انثنى
ولا يدك ارتدت
ولا حده نبا.
إن أدنى حظ من رهافة الحس الموسيقي ليشهد بما قد أسبغته جودة تقطيع النظم على هذا الشعر من عذوبة إيقاع.
وخاتمة القول أن ابن الأثير لم يعد الصواب حين جعل ميزة البحتري العليا أنه أراد أن يشعر فغنى. فلقد ظهر لنا في كل ما تقدم أن أجمل ما بني عليه شعر البحتري هو الجرس الموسيقي وما يشيعه إنشاده من طرب في أجزاء النفس.
وليس يقلل حكم ابن الأثير من علو منزلة البحتري بين الشعراء العرب. فإن ميزة الجرس الموسيقي ليست بالميزة اليسيرة ولا سيما في الشعر الغنائي، بل لعلها هي الميزة العليا في هذا الضرب من الشعر.
ولكن لا بد من الإقرار بأن الجرس الموسيقي الذي يتحلى به نظم البحتري قليل النصيب من الفخامة والروعة، فهو جرس عذب رقيق وكفى. أنه قد عدم ذلك العزف الصاخب القوي الذي نجده في شعر زميله أبي الطيب المتنبي.
من شعره
قال:
طيف لعلوة ما ينفك يأتيني | يصبو إلي على بعد ويصبيني |
تصرم الدهر لا جود فيطمعني | فيما لديك ولا بأس فيسليني |
ولست أعجب من عصيان قلبك لي | عمدا إذا كان قلبي فيك يعصيني |
أما وما احمر من ورد الخدود ضحى | واحور في دعج من أعين العين |
لقد حبوت صفاء الود صائنه | عني وأقرضته من لا يجازيني |
هوى على الهون أعطيه وأعهدني | من قبل حبك لا أعطي على الهون |
شغلان من عذل ومن تفنيد | ورسيس حب طارف وتليد |
وأما وآرام الظباء لقد نأت | بهواك آرام الظباء الغيد |
طالعن غورا من تهامة واعتلى | عنهن رملا عالج وزرود |
لما مشين بذي الأراك تشابهت | أعطاف قضبان به وقدود |
في حلتي حبر وروض فالتقى | وشيان وشي ربى ووشي برود |
وسفرن فامتلأت عيون راقها | وردان ورد جنى وورد خدود |
وضحكن فاغترف الأقاحي من ندى | غض وسلسال الرضاب برود |
نرجو مقابلة الحبيب ودونه | وخد يبرح بالمهارى القود |
ومتى يساعدنا الوصال ودهرنا | يومان يوم نوى ويوم صدود |
هل دين علوة يستطاع فيقتضى | أو ظلم علوة يستفيق فيقصر |
بيضاء يعطيك القضيب قوامها | ويريك عينيها الغزال الأحور |
تمشي فتحكم في القلوب بدلها | وتميس في ظل الشباب وتخطر |
وتميل من لين الصبا فيقيمها | قد يؤنث تارة ويذكر |
إني وإن جانبت بعض بطالتي | وتوهم الواشون أني مقصر |
ليشوقني سحر العيون المجتلى | ويروقني ورد الخدود الأحمر |
تناءت دار علوة بعد قرب | فهل ركب يبلغها السلاما |
وجدد طيفها عتبا علينا | فما يعتادنا إلا لماما |
وربت ليلة قد بت أسقى | بعينيها وكفيها المداما |
وقد علمت بأني لم أضيع | لها عهدا ولم أخفر ذماما |
لئن أضحت محلتنا عراقا | مشرقة وحلتها شآما |
فلم أحدث لها إلا ودادا | ولم أزدد بها إلا غراما |
هذي المعاهد من سعاد فسلم | واسأل وإن وجمت ولم تتكلم |
لؤم بنار الشوق إن لم تحتدم | وضنانة بالدمع إن لم يسجم |
وبمسقط العلمين ناعمة الصبا | حيرى الشباب تبين إن لم تصرم |
بيضاء تكتمها الفجاج وخلفها | نفس يصعده هوى لم يكتم |
رد الجفون على كرى متبدد | وحنى الضلوع على جوى متضرم |
إن لا يبلغك الحجيج فلا رموا | في الجمرتين ولا سقوا من زمزم |
قالت الشيب بدا قلت أجل | سبق الوقت ضرارا وعجل |
ومع الشيب على علاته | مهلة للهو حينا والغزل |
خيلت أن التصابي خرق | بعد خمسين ومن يسمع يخل |
زمن تلعب بي أحداثه | لعب النكباء بالرمح الخطل |
أكبرت نفسي وكرها أكبرت | أن تلقى النبل من كف الأشل |
نطلب الأكثر في الدنيا وقد | نبلغ الحاجة فيها بالأقل |
وإذا الحر رأى إعراضة | من صديق صد عنه ورحل |
ولقد يكثر من أعوازه | رجل ترضاه من ألف رجل |
ومن الحسرة والخسران أن | يحبط الأجر على طول العمل |
أصل النزر إلى النزر وقد | يبلغ الحبل إذا الحبل وصل |
لاحت تباشير الخريف وأعرضت | قطع الغمام وشارفت أن تهطلا |
فترو من شعبان أن وراءه | شهرا يمانعنا الرحيق السلسلا |
أحسن بدجلة منظرا ومخيما | والغرد في أكناف دجلة منزلا |
أرسوم دار أم سطور كتاب | درست بشاشتها مع الأحقاب |
يجتاز زائرها بغير لبانة | ويرد سائلها بغير جواب |
ولربما كان الزمان محببا | فينا بمن فيه من الأحباب |
أيام روض العيش أخضر والهوى | ترب لأدم ظبائها الأتراب |
ترنو فتنقلب القلوب للحظها | مرضى السلو صحائح الأوصاب |
صب يخاطب مفحمات طلول | من سائل باك ومن مسؤول |
حملت معالمهن أعباء البلى | حتى كأن نحولهن نحولي |
يا وهب هب لأخيك وقفة مسعد | يعطي الأسى من دمعه المبذول |
أو ما ترى الدمن المحيلة تشتكي | غدرات عهد للزمان محيل |
إن كنت تنكرها فقد عرف الهوى | قدما معارف رسمها المجهول |
تلك التي لم يعدها قصد الهوى | مالت مع الواشين كل مميل |
عجلت إلى فض الخمار فأثرت | عذباته بمواضع التقبيل |
وتبسمت عند الوداع فأشرقت | إشراقة عن عارض مصقول |
أأخيب عندك والصبا لي شافع | وأرد دونك والشباب رسولي |
ولقد تأملت الفراق فلم أجد | يوم الفراق على امرئ بطويل |
قصرت مسافته على متزود | منه الدهر صبابة وعويل |
وإذا الكرام تنازعوا أكرومة | فالفضل للفضل بن إسماعيل |
لا تطلبن له الشبيبة فإنه | قمر التأمل مزنة التأميل |
قوم إذا عرض الجهول لمجدهم | عطفت عليه قوارع التنزيل |
بات نديما لي حتى الصباح | أغيد مجدول مكان الوشاح |
كأنما يضحك عن لؤلؤ | منظم أو برد أو أقاح |
تحسبه نشوان أما رنا | للفتر من أجفانه وهو صاح |
بت أفديه ولا أرعوي | لنهي ناه عنه أو لحي لاح |
أمزج كأسي بجنى ريقه | وإنما أمزج راحا براح |
يساقط الورد علينا وقد | تبلج الصبح نسيم الرياح |
أغضيت عن بعض الذي يتقى | من حرج في حبه أو جناح |
سحر العيون النجل مستهلك | لبي وتوريد الخدود الملاح |
يا عارضا متلفعا ببروده | يختال بين بروقه ورعوده |
لو شئت عدت بلاد نجد عودة | فنزلت بين عقيقه وزروده |
لتجود في ربع بمنعرج اللوى | قفر تبدل وحشه من غيده |
رفع الفراق قبابهم فتحملوا | بفؤاد مختبل الفؤاد عميده |
وإنا الفداء لمرهف غض الصبا | يوهيه حمل وشاحه وعقوده |
قصرت تحتيه فجاد بخده | يوم الوداع لنا وضن بجيده |
عبثت به عين الرقيب فلم يدع | من نيله المطلوب غير زهيده |
ولو استطاع لكان يوم وصاله | للمستهام مكان يوم صدوده |
أأفاق حب من هوى فأفيقا | أم خان عهدا أم أطاع شفيقا |
إن السلو كما تقول لراحة | لو راح قلبي للسلو مطيقا |
هنا العقيق وفيه مرأى مونق | للعين لو كان العقيق عقيقا |
أشقيقة العلمين هل من نظرة | فتبل قلبا للغليل شقيقا |
وسمتك أردية السماء بديمة | تحيي رجاء أو ترد عشيقا |
فلرب يوم غنينا نجتلي | مغناك بالرشأ الأنيق أنيقا |
كذب العواذل أنت أقتل لحظة | وأغض أطرافا وأعذب ريقا |
يعيب الغانيات علي شيبي | ومن لي أن أمتع بالمعيب |
ووجدي بالشباب وإن تقضى | حميدا دون وجدي بالمشيب |
في الشيب زجر له لو كان ينزجر | وبالغ منه لولا أنه حجر |
وللفتى مهلة في الحب واسعة | ما لم يمت في نواحي رأسه الشعر |
قالت مشيب وعشق أنت بينهما | وذاك في ذاك ذنب ليس يغتفر |
وعيرتني سجال العدم جاهلة | والنبع عريان ما في فرعه ثمر |
وما الفقير الذي عيرت آونة | بل الزمان إلى الأحرار مفتقر |
لم يبق من جل هذا الناس باقية | ينالها الفهم إلا هذه الصور |
إدا محاسني اللاتي أدل بها | كانت ذنوبي فقل لي كيف اعتذر |
أهز بالشعر أقواما ذوي وسن | في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا |
علي نحت القوافي من مقاطعها | وما علي لهم أن تفهم البقر |
أخذت ظهور الصالحية زينة | عجبا من الصفراء والحمراء |
نسج الربيع لربعها ديباجة | من جوهر الأنوار بالأنواء |
بكت السماء بها رذاذ دموعها | فغدت تبسم عن نجوم سماء |
في حلة خضراء نمنم وشيها | حوك الربيع وحلية صفراء |
فأشرب على زهر الرياض يشوبه | زهر الخلود وزهرة الصهباء |
صنت نفسي عما يدنس نفسي | وترفعت عن جدا كل جبس |
وتماسكت حين زعزعني الدهر | التماسا لتعسي ونكسي |
بلغ من صبابة العيش عندي | طففتها الأيام تطفيف بخس |
وبعيد ما بين وارد رفد | علل شربه ووارد خمس |
واشترائي العراق خطة غبن | بعد بيعي الشآم بيعة وكس |
وقديما عهدتني ذا هنات | آبيات على الدنيات شمس |
وإذا ما جفيت كنت حريا | أن أرى غير مصبح حيت أمسي |
حضرت رحلي الهموم فوجهت | إلى أببض المدائن عنسي |
أتسلى عن الحظوظ وآسى | لمحل من آل ساسان درس |
ذكرتنيهم الخطوب التوالي | ولقد تدكر الخطوب وتنسي |
وهم خافضون في ظل عال | مشرف يحسر العيون ويخسي |
مغلق بابه على جبل القبق | إلى دارتي خلاط ومكس |
حلل لم تكن كأطلال سعدى | في قفار من البسابس ملس |
ومساع لولا المحاباة مني | لم تطقها مسعاة عنس وعبس |
نقل الدهر عهدهن عن الجد | ة حتى غدون أنضاء لبس |
فكأن الجرماز من عدم الأ | نس وإخلاله بنية رمس |
لو تراه علمت أن الليالي | جعلت فيه مأتما بعد عرس |
وهو ينبيك عن عجائب قوم | لا يشاب البيان فيهم بلبس |
فإذا ما رأيت صورة أنطا | كية ارتعت بين روم وفرس |
والمنايا مواثل وأنوشروان | يزجي الصفوف تحت الدرفس |
في اخضرار من اللباس على | أصفر يختال في ضبيعة ورس |
وعراك الرجال بين يديه | في خفوت منهم وأغماض حرس |
من مشيح يهوى بعامل رمح | ومليح من السنان بترس |
تصف العين أنهم جد أحيا | ء لهم بينهم إشارة خرس |
يغتلي فيهم ارتيابي حتى | تتقراهم يداي بلمس |
فد سقاني ولم يصرد أبو الغوث | على المعسكرين شربة خلس |
من مدام تقولها هي نجم | أضوأ الليل أو مجاجة شمس |
وتراها إذا أجدت سرورا | وارتياحا للشارب التحس |
أفرغت في الزجاج من كل قلب | فهي محبوبة إلى كل نفس |
وتوهمت أن كسرى أبرويز | معاطي والبلهبذ أنسي |
حلم مطبق على الشك عيني | أم أمان غيرن ظني وحدسي |
وكأن الإيوان من عظم الصنعة جوب | في جنب أرعن جلس |
يتظنى من الكآبة أن يبدو | لعيني مصبح أو ممسي |
مزعجا بالفراق عن أنس ألف | عز أو مرهفا بتطليق عرس |
عكست حظه الليالي وبات | المشتري فيه وهو كوكب نحس |
فهو بيدي تجلدا وعليه | كلكل من كلاكل الدهر مرسي |
لم يعبه أنه بز من بسط الديباج | واستل من ستور الدمقس |
مشمخر تعلو له شرفات | رفعت في رؤوس رضوى وقدس |
لابسات من البياض فما تبصر | منها إلا غلائل برس |
لي يدرى أصنع أنس لجن | سكنوه أم صنع جن لأنس |
غير أني أراه يشهد أن لم | يك بانيه في الملوك بنكس |
فكأني أرى المراتب والقو | م إذا ما بلعت آخر حسي |
وكأن الوفود ضاحين حسرى | من وقوف خلف الزحام وجلس |
وكأن القيان وسط المقاصير | يرجعن بين حو ولعس |
وكأن اللقاء أول من أمس | ووشك الفراق أو أمس |
وكأن الذي يريد أتباعا | طامع في لحوقهم صبح خمس |
عمرت للسرور دهرا فصارت | للتعزي رباعهم والتأسي |
فلها أن أعينها بدموع | موقفات على الصبابة حبس |
ذاك عندي وليست الدار داري | باقتراب منها ولا الجنس جنسي |
غير نعمى لأهلها عند أهلي | غرسوا من رطابها خير غرس |
أيدوا ملكنا وشدوا قواه | بكماة تحت السنور حمس |
وأعانوا على كتائب أربا | ط بطعن على النحور ودعس |
وأراني من لعد أكلف بالأشراف | طرا من كل سنخ وأس |
وقفنا والعيون مشغلات | يغالب دمعها نظر كليل |
نهته رقبة الواشين حتى | تعلق لا يغيض ولا يسيل |
قال المرتضى في الأمالي: لأبي عبادة البحتري في وصف الخيال الفضل على كل متقدم ومتأخر فإنه تغلغل في أوصافه واهتدى من معانيه إلى ما لا يوجد لغيره وكان مشغوفا بتكرار القول فيه لهجا لإبدائه وإعادته وقوله في هذا المعنى أكثر من أن يذكر.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 10- ص: 274