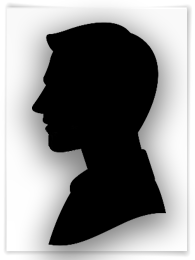أبو نصر الفارابي
أبو نصر الفارابي اسمه محمد بن أحمد بن طرخان.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 438
أبو نصر الفارابي محمد بن أحمد بن طرخان بن اوزلغ
توفي بدمشق سنة 339
أول حكيم نشأ في الإسلام وهو المعلم الثاني وأرسطو المعلم الأول وابن سينا تخرج على كتبه وبتعليقاته تشيخ، نص على ذلك الشيخ أبو عبيد الجوجزاني في تلخيص الآثار. قال بعض المعاصرين كان لا يتصل إلا بأهل الفضل من الشيعة لجامعية العقيدة والمذهب. له كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة والمدينة الجاهلة والمدينة الفاسقة والمدينة المبدلة والمدينة الضالة مطبوع بمصر، قال ومن تأمله عرف إنه من الإمامية العدلية القائلين بعصمة الأئمة عليه السلام. وعن تلخيص الآثار كان اتصاله بالصاحب بن عباد لما كان ببغداد وكان الصاحب شديد الطلب له وحضر أيام إقامته ببغداد على أبي بشر متى بن يونس الحكيم ثم ارتحل إلى يوحنا بن غيلان الحكيم بن حران فأخذ عنه ثم رجع إلى بغداد وتناول كتب أرطاطاليس ثم مضى إلى نحو دمشق الشام واتصل بسلطانها سيف الدولة بن حمدان فأحسن إليه وعرف قدره وكان أزهد الناس في الدنيا وأجرى عليه سيف الدولة في كل يوم أربعة دراهم إلى إن توفي وصلى عليه سيف الدولة في أربعة من خواصه. قال القاضي في المجالس الظاهر إن ذلك كان بوصية منه وله كتب كثيرة. وقال بعض المعاصرين وما يوجد في بعض كتبه من قدم العالم وإنكار المعاد فهو صرف ترجمة لكتب الأقدمين.
قال الدكتور حسين مروة:
المؤرخون يعرفون، بدقة، إن أبا نصر محمد بن أوزلغ الفارابي، قد توفي بشهر رجب عام 339 للهجرة الموافق لشهر كانون الأول عام 950 للميلاد، أي منذ ألف وثلاث عشرة سنة، وإن ذلك كان في دمشق حيث كان في صحبة الأمير سيف الدولة.
المؤرخون يعرفون هذا بدقة وضبط، لأن الفارابي، يوم وفاته، كان المعلم الثاني للفكر البشري بعد معلمه الأول: أرسطو، فكيف يجوز للمؤرخين يومئذ إن يجهلوا، إذن، شيئا من أمره وهو في هذه الذروة العالية من ذروات الفكر البشري.
وإن المؤرخين هؤلاء أنفسهم، يجهلون مع ذلك كيف ولد هذا المعلم، ومتى ولد؟. . . ولولا إن والده كان قائد جيش كما قالوا لجهلوا أيضا أين ولد من الأرض، ولولا أنهم عرفوا إن الموت أدركه وهو في نحو الثمانين، لما استطاعوا إن يفترضوا افتراضا إنه ولد عام 260 أو 257 ه.
والمؤرخون هؤلاء معذرون إن يجهلوا ذلك، لأن المعلم الثاني حين ولد في قرية نائية قرب مدينة فاراب في إقليم خراسان التركي وراء نهر سيحون، إنما ولد في بيت بعيد عن الأضواء التي كان يتهاوى عليها المؤرخون، بعيد عن الخلافة وبلاط الملك ورحاب الجاه. . . وقد كان هؤلاء المؤرخون أكثر ما يغريهم حياة قصر الخلافة وأبهاء البلاط ومضطرب أهل الجاه والسلطان. . . غير إن هذا الفارابي علمهم جميعا، بعد ذلك بل علم التاريخ نفسه، إن بيتا مغمورا في زاوية قصية من الأرض ربما كان خير ألف مرة من ألوف القصور التي وقفوا طويلا في أرجائها يصنعون لها تاريخا من الملق والزلفى، على حين كان التاريخ الحق يجري في سبيله مع الحياة ومع صانعي الحياة من الناس الذين يعملون بجهد أيديهم وعقولهم وقلوبهم في صمت وطيبة وتواضع ودأب.
ويمر المؤرخون سراعا بحياة هذا الفارابي حتى يبلغوه وقد استوى على ذروته العالية في تاريخ المعرفة الإنسانية. وهناك، في أعلى الذروة، نراهم يطوفون في حرم الفكر الذي بناه المعلم الثاني، وهم يجهلون كيف بناه، ويجهلون الأساس الذي قامت عليه هذه المداميك من المعارف والآراء والأفكار والتعاليم. . . يجهلون إن الأساس هو ذلك الفارابي الذي كان ناطورا في بستان في دمشق، وكان مع ذلك دائم الاشتغال بالفلسفة، وكان فقيرا يستضئ في الليل بالقنديل الذي للحارس
فمتى كان الفارابي ناطورا، وفقيرا، ويستضئ بقنديل الحارس، أي حارس البستان الذي هو ناطور له؟.
طبعا، لم يكن كذلك وهو صبي، حين هو كامل الرجولة، لأن الرواية تقول إنه كان حينذاك دائم الاشتغال بالفلسفة، يبني للفكر الإنساني، وللتراث العربي، ذلك البناء الرفيع الفسيح الأرجاء.
ومعنى هذا إن دعائم ذلك البناء قد نهضت على يدي كادح عاش في صفوف الكادحين المغمورين من أبناء الحياة الذين يصنعون تاريخ الحياة. . . ومعنى هذا أيضا إنه قد نهض "المعلم الثاني" للفكر الإنساني على كتفي ناطور البستان الفقير وهو "يستضئ في الليل بالقنديل الذي للحارس".
ولكن المؤرخين يمضون سراعا عن الفارابي الناطور، بعد إن أمضوا سراعا عن الفارابي "المهاجر" من وراء نهر سيحون في خراسان إلى بغداد، ثم عن الفارابي "المشرد" من بغداد إلى حلب، فدمشق حيث أقام "ناطورا" في بستان وهو دائم الاشتغال بالفلسفة أنهم يمضون سراعا عن هذا كله، لكي يحدثونا كثيرا كيف التحق الفارابي بحاشية الأمير سيف الدولة أمير حلب، ولكي يحدثونا بهذه المناسبة عن هذا الأمير الذي أكرم المتنبي فمدحه في معظم شعره، وعن المتنبي الذي أكثر من الحكمة في قصائده ثم عن سيف الدولة أيضا كيف تزيا بزي صوفي، حدادا على الفارابي يوم وفاته، بعد إن صلى عليه صلاة الجنازة في خمسة عشر رجلا من خاصته. .
ولو كان المؤرخون مخلصين للتاريخ، وكانوا على وعي لحركة التاريخ، لحدثونا طويلا عن هذه الحياة الزاهدة الكادحة التي عاشها الفارابي وهو دائم الاشتغال بالفلسفة وعن أسباب هذه الهجرة التي هاجرها من وراء سيحون إلى بغداد، وعن أسباب هذا التشرد الذي انتزعه من بغداد عاصمة العلم والحضارة يومئذ، إلى حلب فدمشق. . . ثم لحدثونا طويلا، كذلك عن العلاقة بين هذا كله وبين المدينة الفاضلة التي ابتدعها الفارابي، وهم يحسبون إنه ابتدعها من محض العلم ومن خالص النظر الفلسفي التجريدي ولحدثونا طويلا عن تلك الصلة بين تفكير الفارابي المعلم الثاني والفارابي الإنسان الذي كان من زهده بالمال إنه لم يكن يتناول من سيف الدولة من جملة ما ينعم به عليه، سوى أربعة دراهم فضة في اليوم يخرجها فيما يحتاج إليه من ضروري عيشه، ولم يكن معتنيا بهيئته، ولا منزل ولا مكسب له، وكان يتغذى بماء قلوب الحملان مع الخمر الريحاني، وكان يخرج إلى الحراس بالليل يستضئ بمصابيحهم فيما يقرؤه.
وما بالنا نطيل اللوم للمؤرخين القدامى، وفي عصرنا هذا مؤرخون كذلك لم يحدثونا كثيرا ولا قليلا عن هذه الصلة بين الفارابي الكادح المشرد من خراسان إلى بغداد فحلب فدمشق، وبين الفارابي صاحب المدينة الفاضلة والمعلم الثاني للفكر الإنساني بعد أرسطو؟. .
والواقع إن الصلة بين نشأة الفارابي وطبيعة حياته الكادحة، وما وعاه في بغداد من مظاهر التفسخ الاجتماعي والسياسي، ومن المظالم النازلة بجمهرة الناس، وما رآه بعد من أحداث الفتن، ومن هجوم الديلم على بغداد، ثم ما أحدثوا في أهل بغداد من شغب وتقتيل وتفظيع، ثم ما لقيه هو في تشرده عنها من أهوال، وما استوعبه من بدوات الانحلال الاجتماعي في تلك المرحلة الزمنية نقول: الواقع إن الصلة بين هذا كله وبين الآراء والأفكار والتعاليم التي تشتمل عليها المدينة الفاضلة، لهي صلة قوية ظاهرة، بحيث لا يستطيع المؤرخ الواعي لحركة التاريخ إلا أن يتعمقها درسا وتوضيحا.
ذلك إن الفارابي يرينا في هذه المدينة الفاضلة ناسا اجتماعيين يؤثرون خير الجماعة على خير ذواتهم الفردية وهم متعاونون جميعا في شكل هرمي منظم يتصل رأسه بقاعدته اتصالا محكما بوسائط مترابطة متفاعلة، يسودهم حب العدل على أساس من الخير والمعرفة، وعلى أساس من القصد إلى العدل والخير والمعرفة. .
والفارابي يرى إن رئيس هذه المدينة الفاضلة لا يستحق رئاسة الهرم الاجتماعي إلا إن يكون تام أعضاء الجسد، حسن الفهم والتصور، جيد الحفظ لما يفهم، ذكيا حاد الذكاء، فصيحا لطيف الأداء، محبا للتعليم والاستفادة لا يؤذيه تعب التعليم، ولا يؤذيه الكد الذي يناله منه، غير طامع نهم شره، محبا للصدق وأهله، مبغضا للكذب وأهله، كبير النفس، محبا للكرامة، تكبر نفسه عن كل ما يشين من الأمور، محبا بطبعه للعدل وأهله، مبغضا للظلم وأهله، قوي العزيمة، غير ضعيف النفس. ويحس الفارابي إن إنسانا فردا تجتمع له هذه الخصال جميعا، قد يكون نادر الوجود في المجتمع، فليكن معه رئيس آخر، أو فليكن للمدينة الفاضلة عدة رؤساء تتجمع فيهم تلك الخصال، حتى تكون المدينة فاضلة حقا برئاستهم مجتمعين مؤتلفين يكمل بعضهم بعضا، فلا سيطرة ولا استبداد ولا طغيان لفرد على مجموع.
ويحدثنا الفارابي عن ألوان مختلفة من المدن المختلفة عن مدينته الفاضلة، فإذا هذه الألوان المغايرة لها كما يصفها ليست من بدع الخيال، والفلسفة المجردة، أو الافتراض العلمي، وإنما هي من المجتمع نفسه الذي عايشه الفارابي، واستوعب أحداثه، واتصل بحياة الكادحين من أهله، وعرف الكثير الكثير من مساوئه ونقائصه ومظالمه.
وأكره ما يكره الفارابي من المدن المضادة لمدينته، إن تكون تلك المدن الجاهلة الضالة قائمة على القهر والقوة والغلبة، لا على العدل والفضيلة والخير والمعرفة والتعاون الصادق، وما أقرب الشبه بين هذه المدن الجاهلة الضالة كما يصفها وبين المجتمعات التي تسودها الأنظمة الفاشستية التي عرفنا منها في عصرنا أشكالا كثيرة.
ويرى الفارابي إن المجتمعات الإنسانية الكاملة كما يتصورها ثلاثة: مجتمع يشمل سكان الأرض جميعا ويسميه الجماعة العظمى، ومجتمع يشمل أمة في جزء من المعمورة ويسميه الجماعة الوسطى، ومجتمع يختص أهل مدينة في جزء من مسكن أمة ويسميه الجماعة الصغرى. . . فإذا ضاق المجتمع عن ذلك كان، في نظره، مجتمعا غير كامل، بعيدا عن الخير الأفضل.
إننا نستنتج من هذه الصور إن المدينة الفاضلة ليست سوى انعكاس عن أشواق عصره ومجتمعه إلى العدل المفقود فيهما، وإن أضدادها ليست سوى انعكاس عن واقع مجتمعه وعصره هذين، وعن الواقع الذي عاش في صميم تجاربه بين غمار الكادحين.
هذا جانب الواقعية الحية في المدينة الفاضلة. وهناك الجانب الفكري الذي نلحظ في ثناياه بذور تفكير مادي عند الفارابي. وذلك حين نراه يقول بان الأجسام الطبيعية أي المادية هي الكائنة وحدها في عالمنا هذا، أما النفس فليست في رأيه منفصلة عن مادة هذه الأجسام، وإنما هي قوى تتدرج من القوة السفلى إلى القوة العليا، وإنما العليا صورة للسفلى وليست منقطعة عنها ذات وجود مستقل، وأرقى هذه القوى جميعا، الفكر. فالنفس عنده تكميل وجود الجسم، والعقل يكمل النفس، والإنسان هو العقل.
ولقد كان من ترابط جوانب الحياة، في مذهبه، إنه يرى علاقة وحدة بين جميع العلوم والمعارف الإنسانية. ونظرية المعرفة عنده قائمة على ما يستفاد من تجارب الحواس وتصوراتها.
نقل عنه ابن طفيل إنه ذكر في شرحه لكتاب أرسطو في الأخلاق، قوله بان أرقى ما يصل إليه الإنسان هو في هذه الدنيا، وإن الخير الاسمي هو أيضا في هذه الدنيا.
وبعد، فان فضل الفارابي على الفكر الإنساني عدا أعماله الإبداعية إنه ضبط كتب المعلم الأول: أرسطو، وصنفها، وأنه هو وتلاميذه ترجموها إلى اللغة العربية وشرحوها، وإن كل من جاء بعده سار على طريقته، وأنه أضاف إلى أرسطو الكثير من آرائه وأفكاره.
وتراث الفارابي من تراث الفكر العربي في الصميم، فهو قد كتب بلغة العرب وطبع بطابع التفكير العربي، وانعكست فيه حياة المجتمع العربي، وبرزت ملامح الشخصية العربية. . . ثم هو من تراث الفكر الإنساني في الصميم كذلك، لأنه نقل إلى الأجيال الإنسانية أعظم ما أنتجه عقل المعلم الأول وأغناه وطوره بابداعاته الخاصة.
أفليس من حق الفارابي، إذن، بل من حق الفكر العربي والفكر الإنساني، على مفكري العرب ومفكري سائر الشعوب أن يحيوا ذكراه الألف، وفاء للإنسان العظيم الذي شغلت المشكلة الإنسانية جانبا عظيما من عبقريته، واستأثرت بمعظم هموم حياته وتفكيره؟. .
وقال قدري حافظ طوقان:
يرى الفارابي في مدينة إن السعادة ممكنة على وجه الأرض. . . إذا تعاون المجتمع على نيلها بالأعمال الفاصلة ". . . إن كل مدينة يمكن إن تنال بها السعادة ولكن أكمل اجتماع إنساني هو الاجتماع الذي يشتمل على جميع أمم الأرض وأحسن دولة تنال بها السعادة هي الدولة الكبرى. . . ".
فالفارابي قد تنبأ إذن باجتماع الأمم كلها واتصالها بعضها ببعض واتحادها فكأنه رجل من رجال القرن العشرين يؤمن بالسلام وثيق برسالة منظمة الأمم المتحدة. . . فلم يقتصر على تنظيم مدينة ضيقة كأفلاطون وغيره، بل فكر باتحاد الأمم كلها. ويقول الدكتور جميل صليبا إن الفارابي بمدينته كان أوسع أفقا وتصورا من فلاسفة اليونان.
وقال الأستاذ فؤاد عينتابي:
الاحتفالات بذكراه
احتفل العالم الإسلامي والبلاد العربية في أواخر العام 1950 الميلادي بالذكرى الألفية لوفاة الفارابي، الفيلسوف الإسلامي الكبير الملقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو. ولهذه المناسبة أقامت جامعتا أنقرة وإستانبول في 29 كانون الأول 1950 احتفالات شائقة ألقيت فيها الخطب والمحاضرات وبحث فيها عن مقام الفارابي في الفلسفة والحضارة الإسلامية والعصر الذي عاش فيه من نواحيه الاجتماعية والسياسية والفكرية. وأصدرت الحكومة التركية طوابع بريد خاصة لذكرى الفارابي ذات ألوان متعددة، كتب عليها: الفارابي الفيلسوف التركي ونشرت أيضا الصحف التركية مقالات عديدة عن الفارابي: حياته وفلسفته، وبعض المجلات المصرية مقالات عنه واحتفلت دار الإذاعة السورية بذكرى الفارابي فأذاعت بعض القطع الموسيقية وفي مدينة حلب ناد موسيقى رياضي باسم نادي الفارابي، ومدرسة ابتدائية تحمل اسمه.
ويقول الأستاذ أحمد أمين
"ونبغ من الأتراك أبو نصر الفارابي الفيلسوف الإسلامي الكبير وأستاذ كل فيلسوف إسلامي بعده، فإنه كان من فاراب، وهي مدينة من مدن الترك نبغ منها جماعة كبيرة من العلماء، ونبوغ الفارابي من بين الأتراك مفخرة كبيرة لهم، فقد عني بفلسفة أرسطو وأخرجها للمسلمين في شكل جديد، وكان له فضل على كل من اشتغل بالفلسفة من المسلمين بعده.
من هو الفارابي
والفارابي علم من أعلام الإسلام ومن بناة الحضارة العربية، كان له باع طويل في الفلسفة والموسيقي والمنطق. . . ويعده الأتراك الآن فيلسوفا تركيا بالنسبة لأصله وموطنه.
ولد أبو نصر محمد بن طرخان بن أوزلغ في واسج وهي حصن صغير في مقاطعة فاراب (اطرار، أو ترار) ببلاد تركستان حوالي العام 257م هجري (870م) ويروى إن أباه كان قائدا عسكريا، نشأ في بلدته وحصل فيها مبادئ العلوم، ثم رحل إلى إيران فتعلم اللغة الفارسية وانتقلت به الأسفار إلى إن وصل بغداد فتعلم فيها اللغة العربية وأتقنها غاية الإتقان ويقال إنه كان يعرف عدا اللغة التركية والعربية لغات كثيرة أخرى من لغات المشرق المعروفة في زمانه ومنها اليونانية واللاتينية.
ولما دخل بغداد كان بها أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهور، وهو شيخ كبير، كان يقرأ الناس عليه المنطق وهو يقرأ كتاب أرسطو في المنطق ويملي على تلامذته شرحه ويستعمل في تصانيفه البسط والتنزيل، وكان الفارابي يحضر حلقته في غمار تلامذته. درس في بغداد الرياضيات والطب والفلسفة، وأقام كذلك برهة ثم رحل إلى مدينة حران وفيها يوحنا بن حيلان، الحكيم النصراني المتوفى في أيام المقتدر، فاستفاد منه وأخذ عنه طرفا من المنطق أيضا. ثم قفل راجعا إلى بغداد، حيث ألف فيها معظم كتبه، وقرأ بها علوم الفلسفة وتناول جميع كتب أرسطو وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضها وبرز في ذلك على أقرانه وأربى عليهم في التحقيق وأظهر الغوامض المنطقية وكشف سرها وقرب متناولها وجمع ما يحتاج إليه منها في كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعاليم، فجاءت كتبه المنطقية والطبيعية والإلهية الغاية الكافية والنهاية الفاصلة.
ثم انتقل إلى حلب في العام 941 م وقدم على سيف الدولة أبي الحسن علي بن أبي الهيجاء ابن حمدان، فأقام في كنفه مدة يعيش في عزلة متزييا بزي أهل التصوف، حياة هادئة متقشفة بعيدا عن ضوضاء الحياة وصخبها، ولكنه مع هذا وجد في عصر من أزهر عصور النهضة الأدبية، عصر سيف الدولة الذي ازدهرت به العلوم والآداب، وقد أكرمه سيف الدولة وقدمه، وعرف من العلم موضعه ومن الفهم منزلته. ثم رحل في صحبة سيف الدولة إلى دمشق حين استيلائه عليها، وتوجه إلى مصر سنة 338 ه 949 م وقد ذكر الفارابي في كتابه الموسوم بالسياسة المدنية إنه ابتدأ تأليفه في بغداد وأكمله بمصر، ثم عاد إلى دمشق من مصر وتوفي بها في رجب سنة 339 هجرية 950 م عند سيف الدولة علي بن حمدان في خلافة الراضي، وصلى عليه سيف الدولة في خمسة عشر رجلا من خاصته ودفن بظاهر دمشق خارج الباب الصغير.
كان الفارابي فيلسوفا كاملا وإماما فاضلا قد أتقن العلوم الحكمية وبرع في العلوم الرياضية، زكي النفس قوي الذكاء متجنبا عن الدنيا مقتنعا منها بما يقوم بأوده، يسير سيرة الفلاسفة المتقدمين، وكانت له قوة في صناعة الطب وعلم بالأمور الكلية منها، ولم يباشر أعمالها ولا حاول جزئياتها. كان في أول أمره ناطورا في بستان بدمشق، وهو على ذلك دائم الاشتغال بالحكمة والنظر فيها والتطلع إلى آراء المتقدمين وشرح معانيها، وكان ضعيف الحال حتى إنه كان في الليل يسهر للمطالعة والتصنيف ويستضيء بالقنديل الذي للحارس، وبقي كذلك مدة إلى إن عظم شانه وظهر فضله".
كان الفارابي منفردا بنفسه لا يجالس الناس، وكان أزهد الناس في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن ولا معتنيا بهيئة منزل. أجرى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم فضة، اقتصر عليها لقناعته، ويروي إنه كان في أول أمره قاضيا، فلما شعر بالمعارف نبذ ذلك وأقبل بكليته على تعلمها، ولم يسكن إلى نحو من أمور الدنيا البتة. ويذكر إنه كان يخرج إلى الحراس بالليل من منزله يستضئ بمصابيحهم فيما يقرؤونه. وكان في علم صناعة الموسيقي وعملها قد وصل إلى غاياتها وأتقنها إتقانا لا مزيد عليه. ويقال إنه صنع آلة غريبة يسمع منها ألحان بديعة يحرك بها الانفعالات، والغالب إن هذه هي الآلة الموسيقية التي أخرجها من خريطة كانت معه في مجلس سيف الدولة وركب منها عيدانا ولعب بها ألعابا شتى من الموسيقي، وهي قصة مشهورة معروفة. ويذكر فارمر إنه اخترع أو أوجد الرباب والقانون.
مؤلفاته
ألف الفارابي بالمنطق والفلسفة والرياضيات والطب والنبات والموسيقي، فكان من علمائها المبرزين في حلبتها، وتعتمد شهرته الفلسفية على شروحه وتعاليقه على مؤلفات أرسطو. بلغت مؤلفاته حوالي الثمانين، غير إن معظمها فقد، ولا يزال منها حتى الآن حوالي الأربعين: منها 31 باللغة العربية، و 6 بالعبرية، واثنان باللاتينية ويقرر جب إن تأليفه في الطب والموسيقي أصبحت مقاييس لمن بعده، ويضيف إن آثاره في الفلسفة العربية هي التي خلدت اسمه، كانت فلسفته ذات نزعة أفلاطونية، وكان أهم ما يسعى إليه التوفيق بين فلسفة أرسطو وأفلاطون (غالبا كما فهمها أصحاب الأفلاطونية الحديثة) غير إنه ظل قوي الاعتقاد بحقيقة الإسلام، وعمل جهده للتقريب بين الفلسفة اليونانية كوحدة تامة، والمعتقدات الإسلامية وأكثر كتبه أهمية بالنظر للغربيين مؤلفه الذي نحا به نحو جمهورية أفلاطون إلا وهو المدينة الفاضلة، حيث أراد إن يجمع بين الدين والدولة وأن يصف بها حكومة مثالية يحكمها رجال حكماء. إذ "إن رئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن إن يكون أي إنسان اتفق لأن الرئاسة إنما تكون بشيئين: أحدهما إن يكون بالفطرة والطبع معدا لها، والثاني بالهيئة والملكة الإرادية".
وأهم مؤلفاته: المدينة الفاضلة، التعليم الثاني، إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها، ويعتبر أول موسوعة بالشرق، ومن الكتب التي حفظ أصلها العربي كتاب الموسيقي الكبير ألفه للوزير أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي. ويعتقد ماكس مايرهوف إن كتاب الموسيقي هذا هو أثر شرقي يبحث في نظرية الموسيقي وأنه البذرة الأولى لمنشأ علم الأنساب (نسبة الأعداد) أو علم اللوغاريتمات ثم له أيضا: السياسة المدنية والسيرة الفاضلة، ويتضمن كتاب المجموع من مؤلفات أبي النصر الفارابي المطبوع بمصر سنة 1907 م (وهو ثماني رسائل) بعض المسائل والآراء الفلسفية منها: فصوص الحكم مع شرحه نصوص الكلم للأستاذ محمد بدر الدين النعساني.
وللفارابي شرح كتاب البرهان لأرسطو على طريق التعليق، أملاه على إبراهيم بن عدي، تلميذ له بحلب. وذكر شمس الدين سامي إن للفارابي مؤلفا كبيرا في عشرين مجلدا أسماه كتاب في الخطابة".
مناحي فلسفته
تأثرت فلسفة الفارابي بالأفلاطونية الحديثة، وأثرت بدورها على آراء ابن سينا وابن رشد، حتى إن فوكارادي يعد الفارابي من كبار فلاسفة الأفلاطونية الحديثة لأن الفارابي كان على معرفة تامة بالفلسفة القديمة ولا سيما في تعليقاته وشروحه على مؤلفات أرسطو وأفلاطون، وهو الذي عرف العرب على كبير فلاسفة اليونان والمعلم الأول: أرسطو.
قسم الفارابي العقل إلى أربعة أقسام: العقل بالقوة، والعقل بالفعل، و العقل المستفاد، والعقل الفعال. وقد ظهر تحمس الفارابي في شرحه لنظرية أزلية العالم وقدمه فالله سبحانه هو المحرك الذي لا يتحرك، المالك للوجود والكمال المطلق، يخرج العالم بواسطة العقل الفعال. وبالنسبة للإنسان فان هذا العقل الفعال هو الصورة النهائية والجزء الوحيد الخالد.
ونرى نزعته الفلسفية وآراءه المثالية وفكرته الدينية واضحة بينة في دعائه الذي يقول فيه:
"إني أسألك يا واجب الوجود ويا علة العلل، يا قديما لم يزل، إن تعصمني من الزلل وأن تجعل لي من الأمل ما ترضاه لي من عمل. . .
"اللهم أنقذني من عالم الشقاء والفناء واجعلني من إخوان الصفاء وأصحاب الوفاء وسكان السماء مع الصديقين والشهداء. أنت الله الذي لا إله إلا أنت، علة الأشياء ونور الأرض والسماء، امنحني فيضا من العقل الفعال، يا ذا الجلال والأفضال، هذب نفسي بأنوار الحكمة وأوزعني شكر ما أوليتني من نعمة، أرني الحق حقا وألهمني أتباعه، والباطل باطلا واحرمني اعتقاده واستماعه، هذب نفسي من طينة الهيولى، إنك أنت العلة الأولى:
يا علة الأشياء جمعا والذي | كانت به عن فيضه المتفجر |
رب السماوات الطباق ومركز | في وسطهن من الثرى والأبحر |
إني دعوتك مستجيرا مذنبا | فاغفر خطيئة مذنب ومقصر |
هذب بفيض منك رب الكل من | كدر الطبيعة والعناصر عنصري |
اللهم ألهمني الهدى وثبت إيماني بالتقوى وبغض إلى نفسي حب الدنيا، اللهم قو ذاتي على قهر الشهوات الفانية، وألحق نفسي بمنازل النفوس الباقية، واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية، في جنات عالية. . .
اللهم إنك قد سجنت في سجن من العناصر الأربعة ووكلت بافتراسها سباعا من الشهوات، اللهم جد لها بالعصمة وتعطف عليها بالرحمة التي هي بك أليق وبالكرم الفائض الذي هو منك أجدر وأخلق، وامنن عليها بالتوبة العائدة بها إلى عالم السماوي، وعجل لها بالأوبة إلى مقامها القدسي، واطلع على ظلمائها شمسا من العقل الفعال، وأمط عنها ظلمات الجهل والضلال، واجعل ما في قواها بالقوة كامنا بالفعل، وأخرجها من ظلمات الجهل إلى نور الحكمة وضياء العقل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. . .
وفي شعره التالي يعبر عن رأيه في الحياة وزهده بالدنيا داعيا إلى الأخذ بحقائق الأمور والانصراف عن نزوات النفس والحواس، واللهو والعبث، فالدنيا كما يراها دار زوال وفناء لا تستقر على حال. . .
لما رأيت الزمان نكسا | وليس في الصحبة في انتفاع |
كل رئيس به ملال | وكل رأس به صداع |
لزمت بيتي وصنت عرضا | به من العزة اقتناع |
اشرب مما اقتنيت راحا | لها على راحتي شعاع |
لي من قواريرها ندامى | ومن قراقيرها سماع |
واجتني من حديث قوم | قد أقفرت منهم البقاع |
وله أيضا:
أخي خل حيز ذي باطل | وكن للحقائق في حيز |
فما الدار دار خلود لنا | ولا المرء في الأرض بالمعجز |
وهل نحن إلا خطوط وقعن | على كرة وقع مستوفز |
ينافس هذا لهذا على | أقل من الكلم الموجز |
محيط السماوات أولى بنا | فلم ذا التزاحم في المركز؟! |
وقال محمد مصطفى حلمي:
- 1 -
الفارابي الفيلسوف الروحي
كان أبو نصر الفارابي فيلسوفا مسلما على الحقيقة، وفيلسوفا عقليا ينزع في فلسفته منزعا روحيا باسمى ما في الفلسفة العقلية والروحية من المعاني الدقيقة، فقد كانت سيرته في حياته العملية، وفلسفته في حياته العقلية، ونزعته في حياته الروحية، آيات على إنه قد وجد في العقل والروح أصفى مورد يروي منه، وأنقى منبع يصدر عنه، وأرقى مبدأ يعول عليه، ويعلل به، ويقيم حياته وحياة أشباهه الفردية، كما يقيم حياة المدن وحياة الأمم الاجتماعية، على دعائم عقلية وروحية، هي قوام السعادة الحقيقية التي تطمح إلى تحقيقها الإنسانية.
والمتأمل فيما كان يأخذ به الفارابي نفسه في حياته، وفيما كان يصور به منهجه ومذهبه ومسلكه في هذه الحياة الدنيا، وفيما كان يبتغي به وجه الله في الحياة الأخرى، وفيما كان يريد إن يحققه لنفسه وأن يحققه غيره في الحياتين من السعادة القصوى والبهجة العظمى، يلاحظ إنه في كل أولئك أدنى إلى الصوفي التقي، والزاهد الخلي، والورع التقي، الذي ينصرف عما في الحياة من متاع حسن وجاه مادي، ويقبل على كل ما فيها من نعيم عقلي وخلود روحي، فإذا هو يجد في الخلوة والعزلة ملاذه، وفي التفكر والتدبر عياذه، وفي اشتغال عقله بالحقائق، وتذوق روحه للرقائق، أقصى ما تسكن إليه وتطمئن به نفس الفيلسوف الحكيم، من فردوس العقل الدائم ونعيم الروح المقيم.
وليس أدل على ذلك المنزع الفلسفي الصوفي الذي نزعه الفارابي في حياته العقلية والروحية، أبياته العينية:
وليس أدل عليه أيضا من قوله في دعائه الذي كان يتضرع به إلى ربه فيقول:
إلى إن يقول:
". . . اللهم طهر بروح القدس الشريفة نفسي، وآثر بالحكمة البالغة عقلي وحسي، واجعل الملائكة بدلا من عالم الطبيعة أنسي. . . اللهم قو ذاتي على قهر الشهوات الفانية، وألحق نفسي بمنازل النفوس الباقية، واجعلها من جملة الجواهر الشريفة الغالية، في جنات عالية. . . "
فواضح هاهنا إن الأبيات الستة الأولى إنما هي تعبير صادق عن حياة العزلة التي آثرها الفارابي بعد ما رأى من مساوئ الزمان وصحبة أهله التي لا تنفع، وحتى يستطيع إن ينجو بعرضه وعزته وكرامته، وأن يخلو إلى نفسه وتأمله وفلسفته، وأن يخلص من هذا كله إلى صفاء عقله وقلبه، وإلى انفصاله عن الحياة المادية واتصاله بالحياة الروحية في ظل ربه، حيث يشعر ويتذوق وحيث يفكر ويتحقق، وحيث ينظر ويتعمق، وحيث يكون بعد هذا كله أصفى وأطهر ويكون نصيبه من العادة أوفى وأوفر، على نحو ما يرجوه في دعائه الذي يناجي به ربه من قهر ذاته للشهوات الفانية، وإلحاق نفسه بالنفوس الباقية وإحلال روحه محلا رفيعا في جنات عالية. ويؤيد نزوع الفارابي هذا المنزع الصوفي الروحي ما ذكره عنه ابن خلكان في ترجمته له من إنه كان منفردا بنفسه، لا يجالس الناس، ومن إنه أبان إقامته
بدمشق لم يكن غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض، ومن إنه كان أزهد الناس في الدنيا، لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن، وأنه كان من القناعة بحيث اقتصر على أربعة دراهم كل يوم كان يجريها عليه سيف الدولة الحمداني من بيت المال.
على إن هذا الطابع الصوفي الذوقي وما تطبع به نفس صاحبه من كمال في العلم والعمل هو سبيله إلى التحقق بالحقائق العلية، والتخلق بالأخلاق الرضية، لم يكن مقصورا عند الفارابي على تلك الحياة الروحية النقية التي كان يحياها الفيلسوف فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين أشباهه، وفيما بينه وبين ربه وإنما هو طابع لا يكاد ينفك عن كثير من النواحي العقلية الخالصة للفلسفة النظرية والعملية لهذا الفيلسوف بل إنه ليجعل من كثير من المبادئ والمناهج العلمية والعملية التي تقوم عليها وتقوم بها الحياة الروحية شرطا لا بد منه في طالب الحكمة ومعلمها، ولا منصرف عنه لأهل المدينة الفاضلة ورئيسها فكل أولئك لا يتهيأ لهم العلم الصحيح ولا يصدر عنهم العمل الصالح، ولا تستقيم لهم وبهم أمور معاشهم في الحياة الدنيا ولا يتاح لهم الفوز الأعظم في معادهم في الحياة الأخرى، إلا إذا صلحت نفوسهم باطراح الشهوات، وإلا إذا خلصت قلوبهم إلى الله بالخلاص عن النزوات وإلا إذا صقلت عقولهم فانتقشت فيها حقائق الموجودات.
وحسبنا لنتبين هذا كله إن ننظر مع الفارابي في السبيل التي ينبغي إن يسلكها من أراد تعلم الفلسفة: فهو يرى إن هذه السبيل هي القصد إلى الأعمال وبلوغ الغاية وإنما يكون القصد إلى الأعمال بالعلم إذ إن تمام العلم إنما يكون بالعمل كما إن بلوغ الغاية في العمل إنما يكون بإصلاح الإنسان نفسه أولا ثم بإصلاح غيره ممن يعيشون معه في منزله أو في مدينته. وهو يرى أيضا إن من أراد الشروع في الحكمة فينبغي إن يكون شابا صحيح المزاج متأدبا بآداب الأخيار قد تعلم القرآن واللغة وعلوم الشرع أولا وأن يكون عفيفا صدوقا معرضا عن الفسوق والفجور والخيانة والمكر والحيلة فارع البال عن مصالح معاشه غير مخل بركن من أركان الشريعة ولا بأدب من آدابها معظما للعلم والعلماء ولا يكون لشيء عنده قدر إلا للعلم وأهله ولا يتخذ علمه لأجل الحرفة وإن من كان بخلاف ذلك فهو حكيم زور ولا يعد من الحكماء. .
وحسبنا أيضا إن ننظر مع الفارابي في الحال التي يجب إن يكون عليها الرجل الذي تؤخذ عنه الفلسفة: فهو يرى إن تلك الحال هي إن يكون معلم الفلسفة قد تقدم وأصلح الأخلاق من نفسه الشهوانية، كيما تكون شهوته للحق فقط، لا للذة، وأن يكون قد أصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة كيما يكون ذا إرادة صحيحة.
وحسبنا إن ننظر كذلك مع الفارابي فيما اشترطه من شروط ينبغي إن تتوفر في رئيس المدينة لكي يكون رئيسا فاضلا لمدينة فاضلة مكونة من أفراد فضلاء كلهم من أهل الفضل القادرين على تحصيل السعادة لأنفسهم من ناحية، وعلى تحقيقها لغيرهم من أهل مدينتهم الفاضلة من ناحية أخرى: فعند الفارابي لا يكون رئيس المدينة رئيسا فاضلا لمدينة فاضلة إلا إذا كان حكيما على التمام، ولا يكون حكيما على التمام إلا إن يكون إنسانا قد استكمل من الناحيتين العلمية والعملية بصفة عامة، وأن تكون نفسه الناطقة أو قوته العاقلة قد استكملت بحيث يصير عقلا ومعقولا بالفعل، وأن تكون قوته المتخيلة قد استكملت غاية الكمال بحيث تصبح معدة للتلقي عن العقل الفعال الذي يلقي إليها وإلى القوة العاقلة الفيوضات الآتية من لدن الله، وعنده أيضا إن من استكمل قواه النظرية والعملية والمتخيلة على هذا الوجه، فإنما يكون حكيما فيلسوفا أو متعقلا على التمام، كما يكون نبيا مخبرا بما هو كائن ومنذرا بما سيكون، وهو بحكم ما تهيأ له من أسرار الحكمة وأنوار النبوة، يعد أكمل وأفضل درجات السعادة الحقيقة، وأصبح من أهل المدينة الفاضلة التي يرأسها مثلا أعلى يقتدى به ويهتدى في الحياة النظرية والعملية، بحيث يصبح كل فرد من أفراد هذه المدينة الفاضلة، بمثابة صورة منه أو نسخة عنه.
أما كيف يتهيأ لرئيس المدينة الفاضلة إن يكون كذلك، فذلك ما نتبينه مع الفارابي من خلال الشروط العلمية والعملية التي يشترطها فيه، والتي يرد كثير منها إلى ذلك الطابع الروحي الذي طبعت به حياة الفارابي، وطبع به مذهبه الفلسفي فلا بد لرئيس المدينة الفاضلة من إلا يكون شرها في الشهوات البدنية، من مأكل ومشرب وغيرهما، وذلك على وجه يتجنب معه اللهو والعبث، ويبغض اللذات الحسية الناشئة عن تلك الشهوات البدنية، ومن إن يكون محبا للصدق وأهله، مبغضا للكذب وأهله، ومن إن يكون كبير النفس مترفعا عن كل ما يشين، محبا للكرامة متساميا بنفسه عن كل ما يرفع، ومن إن يهون عنده الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا.
فإذا كان ذلك كذلك، وكانت تلك هي الخصال المحمودة التي ينبغي إن يتحلى بها الرئيس الفاضل للمدينة الفاضلة ومعلم الحكمة وطالبها، والتي ينبغي إن يتحلى بها ويتخلى عن أضدادها كل فرد من أفراد المدينة في حياته النظرية والعملية الفردية والاجتماعية، حتى تكون المدينة فاضلة رافلة في حلل السعادة الحقيقية، فقد تبين إذن إلى أي حد، وعلى أي وجه، يمكن إن يقال إن فلسفة الفارابي الاجتماعية والسياسية إنما تقوم على أسس روحية، وتستمد عناصرها من منابع نفسية وأخلاقية من شأنها إن تطهر النفوس من أدرانها، وأن تجعل من أصحابها أفراد فاضلين في المدينة الفاضلة، وأناس كاملين في الإنسانية الكاملة. ومعنى هذا بعبارة أخرى إن المدينة الفاضلة التي هي دعامة للإنسانية الكاملة، والتي يرأسها حكيم أو نبي قد كملت نفسه ونفوس معاونيه ومواطنيه على هذا الوجه، إنما هي ثمرة روحية بقدر ما هي ضرورة اجتماعية. وأي شيء أدل على صدور المدينة الفاضلة والإنسانية الكاملة عن منابع عقلية وروحية إلى جانب ما تقوم عليه من صنائع علمية وعملية، من إن الرئيس الفاضل إنما هو كما يقول الفارابي من تكون مهنته ملكية مقرونة بوحي من الله تعالى، كما إنه هو الذي يقدر الآراء والأفعال التي في الملة الفاضلة بالوحي، وذلك بأن توحى إليه هذه الأفعال وتلك الآراء مقدرة من ناحية، وبأن يقدرها هو بالقوة التي استفادها هو عن الوحي والموحي تعالى من ناحية أخرى.
هذه طائفة من المنازع الصوفية التي نزع إليها الفارابي الفيلسوف في حياته الروحية، والتي فاضت بها فلسفته النظرية والعملية، في نواحيها العقلية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، والتي طبعت بطابعها المثالي الرائع فكرته الكبرى عن المدينة المثلى، فكان في أنظاره العقلية، وفي أذواقه الروحية، وفي أغراضه الإنسانية، فيلسوفا مثاليا يريد أن يقيم الحياة العملية الإنسانية على دعائم مستمدة من العقل الذكي، والقلب النقي، والضمير الحي، ولقد تألفت هذه المعاني لديه، ثم تمثلت له وتجلت عليه، فإذا هي مدينته الفاضلة.
- 2 -
مع الفارابي في المدينة الفاضلة
ها نحن أولا نقف مع الفارابي في مدينته الفاضلة، لنتبين من خلال هذه الوقفة كيف كانت هذه المدينة الفاضلة عند الفارابي الفيلسوف العقلي والروحي المسلم، مرآة صادفة للحياة الاجتماعية والسياسية، وقد أقيمت على دعائم إسلامية، واستمدت مقوماتها من منابع قرآنية ونبوية، إلى جانب ما أقيمت عليه، واستمدت منه، من الفكرة الأفلاطونية عن الجمهورية:
فرئيس المدينة الفاضلة عند الفارابي فيلسوف يقرب كثيرا أو قليلا مما يصور به أفلاطون في جمهوريته هذا الرئيس وغيره ممن إليهم شؤون الحكم وتدبير السياسة في هذه الجمهورية، ولكنه ليس عند الفارابي فيلسوفا قد صلحت نفسه الناطقة واستعلت على نفسه الشهوية ونفسه المغضبية فحسب، ولا هو يستطيع، بفضل ما أتيح له من صلاح نفسه الناطقة أو قوته العاقلة، أن يتصل بالعقل الفعال الذي يفيض عليه حقائق الموجودات ودقائق المعقولات فحسب، وإنما هو فيلسوف بهذه المعاني كلها، وبمعنى آخر زائد عليها، هو هذا المعنى النبوي الإسلامي الذي يجعل من رئيس المدينة الفارابية فيلسوفا أضفى الله على قوته المتخيلة ثوبا من أثواب النبوة فإذا هو متعقل لما هو موجود، ومخبر بما هو كائن، ومنذر بما سيكون، لأن كلا من قوتيه المتعلقة والمتخيلة قد بلغت من الدقة والرقة، ومن الصفاء والنقاء، بحيث تهيأ لصاحبهما من الكمال، ما يجعله أهلا للتلقي عن الله بطريق الاتصال بالعقل الفعال.
وعن هذه المعاني الكاملة التي تلتقي في رئيس المدينة الفاضلة، وتنتفي عن رئيس المدينة الجاهلة، قد عبر الأستاذ ت. ج دي بور مؤرخ الفلسفة الإسلامية، وذلك في كتاب (تاريخ الفلسفة في الإسلام) فقال:
". . . ولما كان الفارابي رجلا شرقيا في نظرته للأمور، فقد ظن إن معاني الجمهورية الأفلاطونية تتلخص في صورة الرئيس الفيلسوف. يرى الفارابي إن الناس قد دعتهم الضرورة الطبيعية إلى الاجتماع، فهم يخضعون لإرادة رئيس واحد تتمثل فيه المدينة بخيرها وشرها، فتكون فاسدة إذا كان حاكمها جاهلا لقوانين الخير، أو كان فاسقا أو ضالا، أما المدينة الفاضلة فهي نوع واحد، ويرأسها الفيلسوف. والفارابي يصف أميره بكل فضائل الإنسانية، وكل فضائل الفلسفة، فهو أفلاطون في ثوب النبي محمد عليه الصلاة والسلام".
على إن الفارابي الذي نزع في حياته الشخصية منزعا صوفيا، وذهب في فلسفته العامة مذهبا عقليا أضفى عليه في بعض نواحيه ثوبا روحيا، كان كذلك في فلسفته العملية سواء فيما يتعلق بتدبير حياة الفرد مع نفسه، ومع أشباهه ممن يعايشهم ويواصلهم في منزله وفي مدينته، وكان في هذه الفلسفة العملية شيئا آخر فوق ذلك كله.
كان فيلسوفا اجتماعيا وسياسيا بأدق ما في الاجتماع والسياسة من المعاني العلمية والمبادئ العلمية، ولعل نظرته الاجتماعية والسياسية كانت أبعد آفاقا، وأوسع نطاقا، بحيث لم تقف عند حد الفرد في مجتمعاته الصغيرة والكبيرة التي تبدأ من المنزل وتنتهي إلى المدينة، وإنما هي تتجاوز هذه المجتمعات إلى المجتمع الأكبر وهو هذا المجتمع الذي يشمل أفراد الإنسان جميعا شمولا كليا يجعل منهم أمة واحدة فاضلة، تنطوي على أسمى معاني الحق والخير، وتسعى إلى تحقيق أرقى مبادئ التعاون والبر، فإذا الناس لا يحيون في هذه المدينة أو تلك، ولا في هذه الأمة أو تلك، وإنما يحيون في الإنسانية كلها، ويتواصلون بها ويتعاونون من أجلها، فلا يجحف فرد بحق فرد، ولا تتحيف أمة من حق أمة، لأن الأفراد والأمم جميعا قد استظلوا بظل واحد هو ظل الإنسانية.
ويتبين هذا كله إذا لاحظنا مع الفارابي إن كل إنسان قد خلق مفطورا على إنه محتاج إلى غيره، وذلك فيما يتقوم به في حياته، وفيما يعول عليه لبلوغ أفضل كمالاته، وتحقيق أكمل غاياته، لا سيما فيما لا يستطيع إن يحققه ويحقق الكمال فيه لذاته بذاته، وإن هذه الفطرة على حاجة الإنسان إلى الإنسان، وعلى تعاون الإنسان مع الإنسان، هي العلة الأولى في وجود الجماعة المؤلفة من أفراد متكثرين متعاونين يقوم كل منهم لغيره بما يحتاج إليه غيره حتى يبلغ به الكمال.
على إن الجماعات الإنسانية التي تنشأ على هذا الوجه، ليس كلها عند الفارابي سواء، بل منها جماعات كاملة، وجماعات غير كاملة.
والجماعات الكاملة ثلاث:
جماعة صغرى وهي اجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة.
وجماعة وسطى وهي اجتماع أمة في جزء من المعمورة.
وجماعة عظمى وهي اجتماع الجماعة كلها في المعمورة كلها.
وأما الجماعات غير الكاملة فهي اجتماع في منزل، أو اجتماع في سكة، أو اجتماع في محلة، أو اجتماع في قرية.
وهذه الجماعات سواء ما كان منها كاملا أو غير كامل، يرتبط بعضها ببعض، ويقوم بعضها ببعض، ويحتاج بعضها في تحقيق كماله إلى بعض. وإن الفارابي ليظهرنا على هذه المعاني كلها بحيث يظهرنا على معنى التعاون والتضامن بينها، وذلك إذ يقول إن القرية من المدينة بمثابة الخادمة لها، وإن المحلة من القرية بمثابة جزئها، وإن السكة من المحلة بمثابة جزئها، وإن المنزل من السكة بمثابة جزئها، وإن المدينة من الأمة بمثابة جزء من مسكنها، وإن الأمة بمثابة جزء من أهل المعمورة كلها.
وإذا كانت تلك هي مراتب الجماعات، وتسلسل بعضها من بعض، وترتب بعضها على بعض، فقد انتهى الفارابي إلى إن الخير الأسمى، والكمال الأقصى، إنما يتوصل إليه، ويحصل عليه، بالاجتماع في مدينة لا بما دون ذلك من ألوان الاجتماع الذي يقع فيما دون المدينة من جماعات.
وكما إن الجماعات مراتب ودرجات بعضها فوق بعض أو دون بعض، فكذلك المدن ليس كلها سواء فيما تحقق من خير وشر، ولا فيما تقوم عليه من فضل وجهل، ولا فيما تتحقق به من كمال ونقص، ذلك بان هذه كلها غايات يتوسل إلى تحقيقها بالإرادة والاختيار، والإرادة نزوع إلى الخير تارة وإلى الشر تارة أخرى، وللاختيار جنوح إلى الكمال حينا وإلى النقص حينا آخر، والإرادة هي الملكة التي يعملها الإنسان منفردا في نفسه، وتعملها الجماعة مجتمعة فيما بين بعض أفرادها وبعض، وهذا من شانه إن تقوم بين الأفراد صلات على أساس من التعاون على بلوغ غايات بعضها خيرات وبعضها شرور، ومن هنا كانت المدن التي يعمل أهلها إرادتهم في سبيل التعاون على الخير والفضل والكمال، مدنا فاضلة مؤدية بأهلها إلى السعادة، بقدر ما كانت المدن التي يعمل أفرادها إرادتهم في سبيل التعاون على الشر والجهل والنقص مدنا مؤدية بأهلها إلى الشقاء.
ويخلص الفارابي من هذا التسلسل والتدرج في مراتب الجماعات، وما ينبغي إن تحققه كل جماعة من خيرات وكمالات، إلى فكرته الكبرى عن المدينة الفاضلة، التي هي عنده قوام فكرته العليا عن الإنسانية الكاملة، وذلك إذ ينتهي إلى النتيجة التي ترتب على ما قدمه بين يديها من مقدمات، وهي إن المدينة التي يقصد بالاجتماع فيها إلى التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة، كما إن الاجتماع الذي يتعاون به على نيل السعادة هو الاجتماع الفاضل، وكما إن الأمة التي تتعاون مدنها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة، وكما إن المعمورة التي تتعاون مدنها كليا على ما تنال به السعادة هي المعمورة الفاضلة.
ومن الطريف العجيب معا إن يكون الفارابي الفيلسوف الصوفي الروحي في حياته الخاصة، والفيلسوف العقلي والنظري في فلسفته العامة، والذي تقع حياته فيما بين سنتي 259 و 339 للهجرة الموافقتين لسنتي 870 و 950 للميلاد، أسبق من علماء الاجتماع المحدثين والمعاصرين في أوربا وأمريكا، إلى تشبيه المدينة بالجسم الحي، والمقابلة بين كل جزء من أجزاء المدينة وبين كل عضو من أعضاء الجسم. .
فالمدينة الفاضلة عند الفارابي تشبه البدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة الحيوان من ناحية، وعلى حفظ هذه الحياة على الحيوان من ناحية أخرى. فكما إن للبدن أعضاء يتفاوت كل منها عن الآخر في رتبته وقيمته، وفي وظيفته وخدمته، وفيما يؤديه من هذه الخدمة لغيره من الأعضاء، فكذلك للمدينة أفرادهم منها بمثابة الأعضاء من البدن، ولكل منهم في المدينة رتبته وقيمته ووظيفته التي تتفاوت بتفاوت ما يؤديه من خدمة نحو غيره من أفراد مدينته الذين يتصل بهم، ويعمل معهم، فيما يشارك فيه من حياة المدينة، وكما إن في البدن أعضاء رئيسية هي قوام حياته، فكذلك للمدينة أفراد يرأسونها، ويتولون أمرها، وبعضهم مرؤوس لبعض، وكلهم مرؤوس لرئيس أعلى واحد هو منهم في المدينة بمثابة القلب في البدن، وهذه الرتب المتفاضلة والمتكاملة من أعلاها إلى أدناها في أفراد المدينة، هي التي يصورها الفارابي على هذا الوجه الدقيق الذي يدل عليه قوله:
"إن المدينة أجزاؤها مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات وفيها إنسان هو رئيس، وآخر تقرب مراتبها من الرئيس، وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلا يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس، وهؤلاء أولوا المراتب الأول، ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على حسب أغراض هؤلاء، وهؤلاء هم في الرتبة الثانية، ودون هؤلاء أيضا من يفعل الأفعال على حسب أغراض هؤلاء، ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى إن تنتهي إلى آخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم، فيكون هؤلاء هم الذين يخدمون ولا يخدمون، ويكونون في أدنى المراتب وهم الأسفلون (آراء أهل المدينة الفاضلة: صلى الله عليه وسلم 89 80).
على إن الفارابي لا يطلق الموازنة والمقابلة بين أجزاء المدينة وبين أعضاء البدن، إطلاقا تاما دون إن يقيدهما بقيد، أو يحدهما بحد، وإنما هو من الدقة وعمق الفكرة بحيث يظهرنا على إن ثمة فرقا بين ما هو من أجزاء المدينة وبين ما هو من أعضاء البدن، وذلك إذ يبين إن أعضاء البدن طبيعية، وإن الهيئات التي لهذه الأعضاء إنما هي قوى طبيعية، على حين إن أجزاء المدينة وهم أفرادها، وإن كانوا طبيعيين، إلا إن الهيئات والملكات التي يفعلون بها أفعالهم للمدينة ليست طبيعية، وإنما هي إرادية تصدر عن فكر وروية. وهذه الروية وذلك الفكر هما الأداتان اللتان يصطنعهما أهل المدينة فيما هم بسبيل إنشائه واستحداثه من صناعات في مدينتهم، مما يستدل به الفارابي على إن أهل المدينة ليسوا أجزاء لمدينتهم بفطرتهم وحدها، ولا بطبيعتهم وحدها، وإنما هم كذلك بملكاتهم الإرادية، وفرق ما بين الفطرة الطبيعية وبين الملكة الإرادية، كفرق ما بين الغريزة التي لا تفكر وبين العقل الذي يروى ويدبر.
فإذا كان ذلك كذلك، وكانت المدينة بأفرادها، وكان أفرادها بمثابة أجزائها، وكان رئيسها من أفرادها بمثابة القلب من أعضاء البدن، فقد ترتب على هذا كله إن تكون المدينة فاضلة كاملة بقدر ما يتهيأ لأفرادها بصفة عامة من فضل وكمال، وما أتيح لرئيسها بصفة خاصة من استعداد للرئاسة بالعظمة والطبع من ناحية، وبالهيئة والملكة الإرادية من ناحية أخرى، بحيث لا يمكن إن يعدله من هاتين الناحيتين أي من أفراد المدينة، سواء في طبيعته أو في صناعته إذ كما لا يصلح كل إنسان لرئاسة المدينة الفاضلة، فكذلك لا تصلح كل صناعة لتكون على رأس صناعات المدينة الفاضلة، ومن هنا كانت صناعة رئيس المدينة الفاضلة هي الصناعة الرئيسة التي ترأس الصناعات الأخرى في هذه المدينة، ومن هنا أيضا كانت الصناعة الفاضلة للرئيس الفاضل في المدينة الفاضلة هي تؤم الصناعات كلها، وتوجه كل الصناعات الأخرى إلى تحقيق غرضها. وهذا يعني بعبارة أخرى إن المدينة إنما تكون فاضلة بفضل رئيسها، وكاملة بكماله، ذلك بان الفارابي يرى إن رئيس المدينة الفاضلة يجب إن يكون أولا بحيث يكون هو السبب في حصول أجزائها وحفظ بقائها، وبحيث يكون إليه أمر إصلاح أي من تلك الأجزاء إذا اختل أو عرض له فساد.
أما كيف تحقق فكرة الفارابي عن المدينة الفاضلة، وعلى أي وجه يحيا أهلها في ظل رئيس فاضل وسعادة شاملة، وما ذا لهم وعليهم من حقوق وواجبات هي قوام الجماعة الكاملة، فكل أولئك هو ما نوضحه هنا:
- 3 -
مع أهل المدينة الفاضلة
إن الفارابي ليفصل الأمر في مواطن عدة من كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة تفصيلا نتبين خلاله إن للمدينة الفاضلة عنده رؤساء يختلفون في مراتبهم، ويتفاوتون في خدماتهم ولكنهم على تفاوتهم واختلافهم في هذه أو في تلك يعدون جميعا من أهل الفضل والكمال في العلم والعمل، كما نتبين أن الرئيس الأعلى لهؤلاء الرؤساء، وقد امتاز عليهم جميعا بخصائص بعضها فطري وبعضها الآخر كسبي وأعد بها لتدبير أهل المدينة في شؤون معاشهم وتبصيرهم بأمور معادهم يستطيع إن يصوع نفوسهم وقلوبهم وعقولهم صياغة تقومها تقويما سليما وتكونها تكوينا مستقيما، بحيث يجعل منهم مواطنين صالحين، بقدر ما يجعل ممن دونه من الرؤساء حكاما مصلحين، وحراسا عاملين على تحقيق المثل الأعلى في العلم والعمل تحقيقا من شانه إن تصير به نفوسهم وقلوبهم وعقولهم شبيهة بنفس الرئيس الأعلى وقلبه وعقله، فإذا أهل المدينة كلهم من أكبر كبير إلى أصغر صغير حكماء كاملون وعلماء عاملون، ورؤساء مصلحون، ومرؤوسون صالحون، وإذا المدينة فاضلة بفضلهم وكاملة بكمالهم، لأنها إنما هي في حقيقة نشأتها قد قامت بهم وعليهم، وفي طبيعة حياتها قد استمدت منهم واستعانت بهم.
وها هو ذا الفارابي يظهرنا على ما ينبغي إن يتحقق في كل من أهل المدينة الفاضلة من أشياء مشتركة بينه وبين غيره من أهل مدينته من ناحية، ومن أشياء خاصة بكل واحد من أهل المدينة على حدة من ناحية أخرى، تحقيقا لكمال العلم والعمل الذي تحصل به السعادة الكاملة في حياة المدينة الفاضلة، وذلك إذ يرى إن لأهل المدينة الفاضلة أشياء مشتركة يعلمون بعضها ويفعلون بعضها الآخر، وإن لهم أشياء أخرى من علم وعمل تخص كل رتبة من رتبهم، وكل فرد من أفرادهم، وإن كل أولئك إنما يصير به كل فرد من أفراد المدينة الفاضلة في كل رتبها المتكاملة، في حد السعادة على حد تعبير الفارابي نفسه. وأما كيف تحصل هذه السعادة الكاملة لأهل المدينة الفاضلة، فذلك ما بينه الفارابي الفيلسوف الصوفي صاحب المذهب العقلي والمنزع الروحي، في قوله:
". . . فإذا فعل ذلك كل واحد منهم أكسبته أفعاله تلك، هيئة نفسانية جيدة فاضلة، كلما داوم عليها أكثر، صارت هيئته تلك أقوى وأفضل، وتزايدت قوتها وفضيلتها، كما إن المداومة على الأفعال الجيدة من أفعال الكتابة تكسب الإنسان جودة صناعة الكتابة، وكلما داوم على تلك الأفعال أكثر، صارت الصناعة التي بها تكون تلك الأفعال أقوى وأفضل، وتزيد قوتها وفضيلتها بتكرير فعالها، ويكون الالتذاذ التابع لتلك الهيئة النفسانية أكثر، واغتباط الإنسان عليها نفسه أكبر، ومحبته لها أزيد وتلك حال الأفعال التي تقال بها السعادة، فإنها كلما زيدت منها وتكررت، وواظب الإنسان عليها، صيرت النفس التي شأنها إن تستعد، أقوى وأفضل وأكمل، إلى إن تصير من حد الكمال إلى إن تستغني عن المادة، فتحصل متبرئة منها، فلا تتلف بتلف المادة ولا إذا بقيت احتاجت إلى المادة. . . " (آراء أهل المدينة الفاضلة: صلى الله عليه وسلم 93 94). وهاهنا يدخل الفارابي في تفصيلات تتصل بمذهبه في بقاء النفوس مجردة عن الأبدان وفي اتصال بعضها ببعض، والتذاذ بعضها ببعض، بعد هذه المفارقة، وما عساها إن تجد في هذا كله من سعادة قصوى وبهجة عظمى. على إن هذه التفصيلات في هذا المذهب ليست مما يعنينا إن نقف عنده بقدر ما يعنينا إن نقف عند أهل المدينة الفاضلة في حياتهم الفردية والاجتماعية، وما ينبغي إن يحقوه من مثل عليا في العلم والعمل، حتى تتحقق بهم المدينة الفاضلة، وتتحقق لهم فيها السعادة الشاملة.
وإذا كان ذلك هو شان أهل المدينة الفاضلة، وكانت تلك هي سبيلهم ونهايتهم إلى السعادة فليس كذلك الشأن ولا السبيل والنهاية مع أهل المدن التي ليست بفاضلة، والتي ينعتها الفارابي بنعوت مختلفة تجعل منها أصنافا مختلفة، ولكنها على اختلافها تشترك في صفات كلها من قبيل النقص والفساد، ومال أهلها أو بعضهم إلى الهلاك والشقاء: فهناك المدينة الجاهلية، والمدينة المبدلة، والمدينة الفاسقة، والمدينة الضالة، وهناك أيضا مدينة اليسار، ومدينة الخسة والشقوة، ومدينة الكرامة، ومدينة التغلب، ومدينة الهوى: فكل أولئك مدن غير فاضلة يحصيها الفارابي، ويستقصي أسباب النقص فيها، ويبين وسائل أهلها في الحياة وغايتهم منها، ومبلغ قربهم من السعادة أو بعدهم عنها. فالمدينة الجاهلية مثلا هي التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت ببالهم، ولا يعرفون من الخيرات إلا بعض ما يظن إنه خيرات في ظاهر أمره في الحياة كسلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات، وغير ذلك مما يزعمه أهل المدينة الجاهلية خيرات مؤدية لسعادات، والواقع أنها شرور مولدة لشقاوات. وإذا كانت المدينة الجاهلية هي بهذا النعت الصورة الجامعة لمعاني النقص والشر والفساد والشقاء التي تتمثل في أنواع المدن غير الفاضلة الأخرى التي عددها الفارابي ونعت كلا منها بنعت خاص يبين طبيعته وغايته على الوجه الآنف الذكر، فإن في أصناف هذه المدن غير الفاضلة وفيما سمى به كلا منها باسم، تفصيلا لهذا المعنى الجامع من شأنه أن يبين لنا إن المدينة الجاهلية إنما هي من المدن غير الفاضلة بمثابة الجنس من الأنواع، بمعنى إن المدن المبدلة والفاسقة والضالة، ومدن اليسار والخسة والشقوة والكرامة والتغلب والهوى، إنما هي أنواع متعددة لجنس واحد هو المدينة الجاهلية التي تأخذ هذه الصورة أو تلك من صور هذه المدينة غير الفاضلة أو تلك، وجماع معاني النقص والشر والفساد والشقاء التي تتمثل في أنواع المدن الجاهلية هو ما يقوله الفارابي عن أهل هذه المدن من أن: أنفسهم تبقى غير مستكملة، بل هي محتاجة في قوامها إلى المادة ضرورة، إذ لم يرتسم فيها رسم حقيقة لشيء من المعقولات الأول أصلا" (آراء أهل المدينة الفاضلة: صلى الله عليه وسلم 98)، ومناط التفرقة بين أهل هذه المدن الجاهلية وبين أهل المدن الفاضلة هو ما يقوله الفارابي أيضا من إن "أهل المدينة الفاضلة فان الهيئات النفسانية التي اكتسبوها من آراء أسلافهم فهي تخلص أنفسهم من المادة والهيئات النفسانية الرديئة التي اكتسبوها من الأفعال الرذيلة (آراء أهل المدينة الفاضلة 99).
والفارابي الفيلسوف الصوفي الروحي فيما يحصي ويستقصي من أصناف المدن فاضلة وغير فاضلة، وفيما يوازن بين ألوان الحياة الدنيوية والأخروية التي يحياها أهل كل من هذه المدن، لا يكاد ينفك عن مذهبه العقلي الروحي الذي طبع بطابعه حياته الشخصية وتأملاته العقلية وأذواقه الروحية، ولم يكن بد من إن تصطبغ بصبغته الروحية فلسفته الاجتماعية والسياسية، وذلك على الوجه الذي يتمثل فيه ذلك الطابع العقلي والصوفي الروحي الإسلامي تمثلا واضحا جليا في رئيس المدينة الفاضلة، وفيما ينبغي إن يأخذ به نفسه وقلبه وعقله من خضوع لأوامر الشرع وأحكام العقل، خضوعا يجعل منه رئيسا فاضلا على الحقيقة، له من الكمالات الدينية والعقلية والأخلاقية والروحية ما ليس لغيره من أهل مدينته، وله من القدرة على صياغة النفوس والعقول والقلوب التي لأهل مدينته ما يمكنه من إن يجعل منهم أشباها له، يحيون معه في ظل ظليل من التدين والتخلق، ومن التأمل والتحقق، حياة فاضلة في مدينة فاضلة، في عاجلة فاضلة، وتكتب لهم معه بما رقت به نفوسهم، ودقت به قلوبهم، حياة سعيدة في جنة عالية في آجلة خالدة. ويعني هذا كله إن الحياة الدنيوية الفاضلة، والحياة الأخروية الكاملة لا تكون إحداهما أو كلتاهما إلا لمن تخلوا عن الرذائل وتحلوا بالفضائل، وخلصت نفوسهم وعقولهم وقلوبهم من غواش المادة، وذلك بما أحكموا من أصول الدين وقواعد الخلق ومبادئ العقل ومعاني الروح، فأولئك عند الفارابي هم الكاملون، وأولئك عند الله هم الفائزون، وغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم هم الضالون الفاسقون الخاسرون. وهذا يعنى أيضا إنه لا سادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا لأهل المدينة المتدينة، أما المدن الضالة أو المبدلة فالشقاء كل الشقاء لمن أضلهم وبدل الأمر عليهم.
وإذا كان ذلك كذلك، فقد أظهرنا الفارابي على إن أهل مدينته الفاضلة إنما هم مثل أعلى في علمهم وحكمتهم، وفي خلقهم وحياتهم، وفي أذواقهم وأنظارهم وتأملاتهم: فهم في كل أعمالهم لا يصدرون إلا عن الخير، كما أنهم في كل معارفهم لا يصدرون إلا عن الحق، مثلهم في هذا كمثل رئيسهم الذي أخص خصائصه التمسك بأحكام العقل، والتشبث بأصول الشرع، والتعلق بمبادئ الخلق. ولهذا نجد الفارابي يشترط في أهل المدينة الفاضلة إن يشتركوا جميعا في العلم بأشياء لا بد لهم من العلم لها حتى يفضلوا غيرهم وتفضل بهم مدينتهم، ذلك بان من شان العلم بهذه الأشياء، إن يجعلهم حكماء فضلاء سعداء، بقدر ما يجعل الجهل بها من غيرهم من أهل المدن الأخرى سفهاء أدنياء أشقياء، فالسبب الأول، والأشياء المفارقة للمادة، والجواهر السماوية، والأجسام الطبيعية، وكون الإنسان، وكيف تحدث قوى النفس وكيف يفيض عليها العقل الفعال من ضوئه وكيف يكون الوحي، والرئيس الأول والرؤساء الذين ينبغي إن يخلفوه إذا لم يكن موجودا في وقت من الأوقات، والمدينة الفاضلة وأهلها، والسعادة التي تصير إليها أنفسهم والمدن المضادة، للمدينة الفاضلة وما تصير إليه أنفس أهلها بعد الموت. . . كل أولئك أشياء يشترك أهل المدينة الفاضلة في معرفتها، وهم في معرفتهم لها درجات بعضها فوق بعض: حكماء المدينة الفاضلة ويعرفونها ببراهين عقولهم وبصائر نفوسهم، وطائفة هي دون أولئك وهؤلاء، ويعرفون هذه الأشياء بمثالاتها التي تحاكيها، لا بحقائقها التي هي عليها، لأن أذهانهم لا تستطيع إن تدرك ما وراء المثالات والمحاكيات من الحقائق والمعقولات. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فلا بد من إن يصطنع أهل المدينة الفاضلة ما يطلق عليه الفارابي اسم الخشوع، وهو عنده مرآة التدين في هذه المدينة التي يعني فيلسوفنا الصوفي بان يقيمها على دعائم روحية بقدر ما يقيمها على دعائم عقلية. وهو يعني بالخشوع الإيمان بالله، وبان للعالم إلها يدبره، وبان الروحانيين مدبرون ومشرفون على جميع الأفعال، كما إنه يعني به تعظيم الله، والصلاة التسبيح والتقديس له. فهذه كلها أشياء إذا أقبل عليها الإنسان وفعلها، وانصرف عن كثير من الخيرات التي يشتاق إليها في هذه الحياة، وراض نفسه بتلك الأشياء، وواظب عليها، فهنالك يعوض ويكافأ بخيرات عظيمة تتحقق له بعد الموت، وذلك على خلاف ما إذا لم يتمسك بشيء من هذه الأشياء التي تصرفه عن الخيرات الدنيا وتجلب له الخيرات العليا، فإنه عندئذ يعاقب بعد موته بشرور عظيمة تلحقه في حياته الآخرة.
وهكذا يتصور الفارابي أهل المدينة الفاضلة، ويصورهم في هذه الصورة المثالية التي تمثلهم قوما متعقلين متأملين، ومتدينين متخلقين، لا يحيون لدنياهم وحدها، وإنما يحيون لها ولأخراهم أيضا، ويجعلون من حياتهم في الدنيا زادا لحياتهم في الأخرى، وتلك لعمري هي أكمل صورة لأفضل حياة في خير أمة. ولو قد حاول كل فرد من أفراد المدينة الواحدة، وكل مدينة من المدن المختلفة، إن يحقق هذه المبادئ العقلية والدينية والأخلاقية والروحية، في الحياة الفردية والاجتماعية، لنعمت الإنسانية كلها بحياة قوامها الحق والخير والسعادة، وغايتها الأمن والفوز والنجاة.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 103