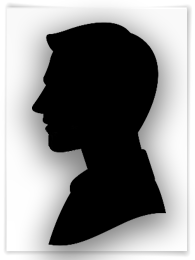علي بن العباس بن جورجس الرومي، أبو الحسن
أبو الحسن علي بن العباس بن جورجس الرومي مولى عبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور
وأمه حسنة بنت عبد الله السجري.
ولد في رجب سنة 221 بالعتيقة من الجانب الغربي من مدينة السلام وتوفي في الجانب الشرقي في مشارع سوق العطش في جمادى الأولى سنة 283 ودفن في مقابر باب البستان وكان ملازما للحسن والقاسم ابني عبيد الله بن سليمان في وزارة أبيهما فيقال إن ابن فراس الكاتب احتال عليه بشيء أطعمه إياه بأمر القاسم بن عبيد الله وكان سبب موته لهجائه ابن فراس.
وهو أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم شعرا وأحسنهم أوصافا وأبلغهم هجاء وأوسعهم افتنانا في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافيه، يركب من ذلك ما هو صعب متناولة على غيره ويلزم نفسه ما لا يلزمه ويخلط كلامه بألفاظ منطقية يجعل لها المعاني ثم يفصلها بأحسن وصف وأعذب لفظ، وهو في الهجاء مقدم لا يلحق فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخبث منطق ولا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه ممن أحسن إليه أو قصر في ثوابه فلذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببا لوفاته، وكانت به علة سوداوية ربما تحركت عليه فغيرت منه. هذا ما قاله المرزباني في معجم الأدباء
القرن الثالث
عاش ابن الرومي في القرن الثالث الهجري وهو قرن امتلأ بأبحاث شتى سياسية، وحركات اجتماعية وأخرى عقلية. قرن التقى فيه العلم بالفلسفة، والتحلل الخلقي بالتصوف، والتقى الأدب واللغة والفقه بمفهوماتها القديمة مع الهندسة والتنجيم والكيمياء والرياضة والمنطق بمفهوماتها الحديثة مع ثمرات النقل والترجمة. وفي هذا القرن تميز العصر العباسي بالتوسع في المصطلحات اللفظية والتوليد في المعاني نظرا لاختلاط العرب بغيرهم والميل إلى التحرر، كما تميز بالتجدد اللفظي بظهور النقد البياني الذي جعل أساس البلاغة في الألفاظ السهولة والحلاوة والجزالة، وكذلك تميز بالتفنن في المعاني الشعرية الخاصة بضروب التمثيل والتشبيه والاستعارة. في خضم هذا العصر الراقي عاش ابن الرومي معاصرا جمهرة طيبة من علماء الدين المعروفين والفلاسفة والأطباء المشهورين، والنحويين والأدباء والشعراء الكبار، والجغرافيين والمؤرخين الثقات. فمن بين علماء الدين نذكر: البخاري والطبري، وابن ماجة. ومن الفلاسفة: الكندي والفارابي. ومن الأطباء: يوحنا بن ماسويه، وابن سهل الرازي. ومن الأدباء: الجاحظ وابن عبد ربه، وابن قتيبة. ومن النحويين: الزجاج، وابن الأنباري، ونفطويه، ومن اللغويين: ابن دريد، وعبد الرحمن الهمذاني، والسجستاني. ومن المؤرخين البلاذري وابن طيفور، والطبري ومن الجغرافيين: ابن الحائك وابن الفقيه. ومن الشعراء: علي بن الجهم وابن المعتز، وغيرهم.
أصله
لم يكن ابن الرومي عربي الأصل، وإنما كان مستعربا، وكانت العربية لغته، قد شب وشاب بين العرب، نطق بلسانهم، وحذق علومهم، واستظل بمدنيتهم، غير أنه احتفظ بطبيعة جنسه حتى صارت روميته المتمسك بها مفتاح شعره ونفسه. وقد وصف العقاد ذلك بقوله: فالرومية هي أصل هذا الفن الذي اختلف به ابن الرومي عن عامة الشعراء في هذه اللغة، وهي السمة التي أفردته بينهم، أفراد الطائر الصادح في غير سربه. وهو يذكر في عدة مواضع في ديوانه إن الروم أصله، وإن كان جده لامه فارسيا، كما إن جده لأبيه رومي. . . فهو القائل:
وإذا ما حكمت والروم قومي | في كلام معرب كنت عدلا |
أنا بين الخصوم فيه غريب | لا أرى الزور للمحاباة أهلا |
شعره
ابن الرومي شاعر فحل، ومصور بارع، دقيق المعاني، عميق الفكر، بديع التصوير، وهو عند ابن رشيق القيرواني، أولى الناس باسم الشاعر لكثرة اختراعه، وحسن افتنانه. وقد أعجب به ابن خلكان فقال: هو صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة، فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة، ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى اخره، ولا يبقى فيه بقية. ويمتاز شعره بطول النفس مع المحافظة على السلاسة، فهو مقتدر على الإسهاب في النسج دون تعب أو تكلف ظاهر، فنحن لا نرى لشاعر عربي ما نراه لابن الرومي من كثرة المطولات التي تتجاوز المئة والخمسين بيتا، وأكثرها حسن السبك، كثير الألوان المعنوية، تدل على غزارة مادته اللغوية ومهارته في استخدام الألفاظ لمعانيه. فهو فياض كثير الإطناب والمراجعة بعيد المدى في ميدان النظم. وقد خالف الشاعر سنة الذين جعلوا البيت وحدة النظم وجعل القصيدة كلا واحدا لا يتم بغير لمام المعنى الذي أراده على النحو الذي نحاه. فقصائده موضوعات كاملة، مؤلفة تأليفا منطقيا وفنيا لا عوج فيه ولا ضعف. ولم يكن ابن الرومي المفرد العلم من شعراء عصره النازع إلى التحليل والتعمق في الشعر، فقد كان أبو تمام شديد النزوع إلى هذا الباب، إلى أبعد الحدود، وقد بلغ الولوع بالمعاني عند الشاعرين حتى أنهما أكثرا من توكيد المعنى بالمعنى في شعرهما. عرف ابن الرومي أنه برع في التمثيل وهو أدق من التشبيه وأكثر لطفا وأجمل صفاء، فقد يكون قصارى الشاعر المشبه إن يشبه ممدوحه بالبحر في الجود، والقمر في السناء، والسيف أو القدر في المضاء، ولكن الشاعر بز بهذه الأبيات التي يمدح فيها أبا القاسم وزير الخليفة المعتضد
بقوله:
إذا أبو قاسم جادت لنا يده | لم يحمد الأجودان: البحر والمطر |
وإن أضاءت لنا أنوار غرته | تضاءل النيران: الشمس والقمر |
وإن نضا حده أو سل عزمته | تأخر الماضيان: السيف والقدر |
من لم يبت حذرا من سطو صولته | لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر |
ينال بالظن ما يعيا العيان به | والشاهدان عليه: العين والأثر |
ويعين ابن الرومي على قدرة الوصاف فيه، عين المصور الماهر، وريشته الساحرة، فقد شغف الشاعر بالحياة وأحب إن يعيش قويا ليتمتع بجمالها وأطايبها، فكان كله شهوات حين يأكل وحين يشرب وحين يجلس إلى مائدة فيصورها بما فوقها من أطايب الطعام. وقد وهبته الطبيعة حسا دقيقا، فكان يرى فيه أدق الألوان وأخفى الأصوات والحركات. وقد ترك لنا أوصافا كثيرة تجعله من كبار الوصافين في الرياض والأزهار والفواكه والطعام والشراب والطيور وبني الإنسان، وقد رسمها في لوحات كاملة رائعة ذات ظلال واضواء جميلة متناسقة خلابة. . . لاحظ كيف يصف رياضا تختال في أزهارها مراقبا صحوات الحياة فيها بدقة وانتباه فيقول:
ورياض تخايل الأرض فيها | خيلاء الفتاة في الابراد |
ذات وشى تناسجته سوار | لبقات بحوكة وغواد |
شكرت نعمة الولي على الوسمي | ثم العهاد بعد العهاد |
فهي تثني على السماء سماء | طيب النشر شائعا في البلاد |
من نسيم كان مسراه في الأرواح | مسرى الأرواح في الأجساد |
حملت شكرها الرياح فادت | ما تؤديه ألسن العواد |
تتداعى بها حمائم شتى | كالبواكي والقيان الشوادي |
من مثان ممتعات قران | وفراد مفجعات وحاد |
تتغنى القران منهن في الأيك | وتبكي الفراد شجو الفراد |
وأبدع في وصف الشيب والشباب والبكاء على عهود الصبا النواضر، فأطال فيها وأجاد متوافرا على استيفاء المعاني وتقصيها، وتدقيقه في رسم الظلال لها، وهو بذلك يسجل أجمل ما قيل في هذا الباب مما يقل نظيره في الأدب العربي.
وفيه يقول مرحبا.
وقلت مسلما للشيب: أهلا | بهادي المخطئين إلى الصواب |
أ لست مبشري في كل يوم | بوشك ترحلي اثر الشباب |
لقد بشرتني بلحاق ماض | أحب إلي من برد الشراب |
فلست مسميا بشراك نعيا | وإن أوعدت نفسي بالذهاب |
وأنت وإن فتكت بحب نفسي | وصاحب لذتي دون الصحاب |
فقد أعتبتني وأمت حقدي | بحثك خلفه عجلا ركابي |
إلى إن يقول:
ذكرني الشباب جنان عدن | على جنات أنهار عذاب |
تفيء ظلها نفحات ريح | تهز متون أغصان رطاب |
إذا ماست ذوائبها تداعت | بواكي الطير فيها بانتحاب |
يذكرني الشباب وميض برق | وسجع حمامة، وحنين ناب |
فيا أسفا ويا جزعا عليه | ويا حزنا إلى يوم الحساب |
أأفجع بالشباب ولا أعزى | لقد غفل المعزي عن مصابي |
تفرقنا على كره جميعا | ولم يك عن قلى طول اصطحاب |
وكانت أيكتي ليد اجتناء | فعادت بعده ليد احتطاب |
ثم استمع إلى تعليقه في حبه للوطن وحنينه إليه وارتباطه الوثيق به:
وحبب أوطان الرجال إليهم | مأرب قضاها الشباب هنالكا |
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم | عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا |
فقد ألفته النفس حتى كأنه | لها جسد، إن بان غودر هالكا |
مدحه
لم يدرك ابن الرومي المعتصم والواثق إلا صبيا صغيرا، وقد أدرك سن البلوغ في زمن المتوكل وعاش إلى خلافة المعتضد، ومع ذلك لا ترى في شعره ما يدل على تقربه من الخلفاء والحظوة عند الأمراء، ولعل السبب أنه لم يدرك منهم غير المستضعفين كالمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد، وكلهم قتل أو خلع أو حكم. وقد عاش مدة أربع سنوات في خلافة المعتضد وله فيه بعض المديح. وهو مدح آل وهب، وآل طاهر، وآل المنجم، وآل نوبخت، وبني المدبر، وبني مخلد وغيرهم. وعلى الرغم من كثرة ممدوحيه فإنه لم يحظ من مدائحه بكبير طائل، رغم قوتها وأصالتها.
وبينما نرى زملاءه من كبار الشعراء كالبحتري قد فاض كسبهم، نراه وهو في الخمسين من عمره يشكو وطأة الزمان، ونار الحرمان فيقول لمن عاب قريضه:
أبعد ما اقتطعوا الأموال واتخذوا | حدائقا وكروما ذات تعريش |
يحاسدوني وبيتي بيت مسكنة | قد عشش الفقر فيه أي تعشيش |
هجاؤه
لم يكن ابن الرومي مطبوعا على النفرة من الناس، ولكنه كان فنانا بارعا في ملكة التصوير ولطف التخيل والتوليد وبراعة اللعب بالمعاني والأشكال، فإذا قصد شخصا أو شيئا صوب إليه مصورته الواعية فإذا ذلك الشخص أو ذلك الشيء صورة مهياة في الشعر تهجو نفسها بنفسها وتعرض لنظر مواطن النقص من صفحتها كما تنطبع الأشكال في المرايا المحدبة، فكل هجوه تصوير مستحضر لأشكاله ولعب بالمعاني على حساب من يستثيره.
رثاؤه
يبرز ابن الرومي بين شعراء الرثاء المجيدين لأبنائهم أمثال أبي ذؤيب الهذلي والقرشي والخنساء وعبد الله بن الأهتم وأبي العتاهية وجرير، وابن عبد ربه، والتهامي وغيرهم. وقد أجاد في مرثية ابنه الأوسط محمد وهي تعد من أرق ما فاضت به عواطف والد على ولد عزيز. وقد استهلها مخاطبا عينيه بقوله:
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي | فجودا فقد أودى نظيركما عندي |
ألا قاتل الله المنايا ورميها | من القوم حبات القلوب على عمد |
توخى حمام الموت أوسط صبيتي | فلله كيف اختار واسطة العقد |
طواه الردى عني فأضحى مزاره | بعيدا على قرب قريبا على بعد |
وقد أبدع في وصف الداء الذي أصابه، وما كان من التأثير فيه، شارحا العواطف، الأبوية المتالمة شرحا يحرك أوتار القلوب. فتصور شدة ألمه وروعة تصويره وأصالة فنه حين يقول:
ألح عليه النزف حتى أحاله | إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد |
وظل على الأيدي تساقط نفسه | ويذوي كما يذوي القضيب من الرند |
واني وإن متعت بابني بعده | لذاكره ما حنت النيب في نجد |
محمد ما شيء توهم سلوة | لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد |
أرى أخويك الباقيين كليهما | يكونان للأحزان أورى من الزند |
إذا لعبا في ملعب لك لذعا | فؤادي بمثل النار عن غير ما قصد |
وقد أرصد الدهر سهامه لابن الرومي في أهله وأسرته، فراح يرثي الراحلين منهم مراثي مؤثرة، فرثى والديه وأمه وخالته وزوجته وأخاه الأكبر. . . ويبدو إن الأحزان لم تعد تشغله عن رزئه في نفسه، فقد كانت فجيعته في حياته أشد وانكى من فجيعته في موت أهله وبنيه:
رأيت الدهر يجرح ثم يأسو | يوسي أو يعوض أو ينسي |
أبت نفسي الهلاع لرزء شيء | كفى شجوا لنفسي رزء نفسي |
وقد يجد أغلبنا راحة وتأسيا في أحزان غيره وبلواهم، فتهون عليه بلواه، ولكن ابن الرومي لا يرى ذلك البتة فيقول:
وما راحة المرزوء في رزء غيره | أيحمل عنه بعض ما يتحمل |
كلا حاملي عب ء الرزية مثقل | وليس معينا مثقل الظهر مثقل |
ورثى الشهيد يحيى العلوي، وهو حفيد حفيد الإمام علي، بمرثية طويلة فاجعة. المؤرخون يظلمون ابن الرومي
ما رجعت مرة إلى سيرة هذا الشاعر العربي إلا أخذني شيء من السخط، أو شيء من الحقد على هؤلاء المؤرخين الذين كتبوا قديما تاريخ الفكر العربي في القرن الثالث الهجري.
فقد رأيت هؤلاء يقتصدون في تاريخ سيرة ابن الرومي اقتصادا يبلغ حد الإجحاف والتقتير، حتى تكاد سيرته لا تتجاوز عندهم بضعة سطور، فإذا تاريخ حياته كلها ينحصر في أن اسمه علي وإن أباه العباس بن جريج أو جورجيس، الرومي أصلا، وإن أمه فارسية، وانه ولد في بغداد عام 221 وانه لم يبرح بغدادا طوال حياته إلا مرة إلى بعلبك وبضع مرات إلى سامراء وما جاورها، ثم هم لا ينسون إن يؤكدوا أنه كان مولى لأحد أحفاد الخليفة العباسي المنصور وهو عبيد الله بن عيسى بن أبي جعفر المنصور.
ولا يبلغ المؤرخون هذا الحد حتى يقفزوا اثنين وستين سنة عاشها ابن الرومي، لكي يقولوا أنه مات عام 283 بقرص مسموم من الحلوى خشكنانجة أطعمه إياه القاسم بن عبيد الله من آل وهب حين كان هذا وزيرا للخليفة المعتضد لكي يتقي شر هجائه.
وعلى رغم هذا الاقتصاد العجيب في تاريخ حياة الشاعر، ترى هؤلاء المؤرخين يفيضون في أخبار تطيره وتشاؤمه، إفاضة تحملك على الظن بان القوم يأتمرون عمدا بهذا الشاعر لكي يمسخوا وجه حياته ويصوروه للأجيال إنسانا ضعيف العقل مهدم الأعصاب، خائر الهمة، تستعبده العاطفة، وتستأثر به الشهوات الحسية إلى حد الغلو والشذوذ في النهم للطعام والشراب والنساء.
ومن هنا حكم هؤلاء المؤرخون على ابن الرومي، أنه لم يكن أهلا للحظوة لدى الملوك ومنادمتهم، وأنه كان من الفاشلين في صناعة المديح، ثم يتزيدون في تشويهه حتى يكون من المسلم عندهم إن ابن الرومي كان حسودا حقودا لئيم الطبع.
والعجيب في هذا كله، إن أكبر المحدثين، ولا سيما بعض المعاصرين، قد تابعوا أولئك الذين كتبوا قديما تاريخ ابن الرومي على هذا الوجه الممسوخ الشائه، فإذا سيرة هذا الشاعر العبقري، تلقى اليوم إلى طلبة المدارس ممسوخة مشوهة تثير ضحك الساخرين أو تثير إشفاق المشفقين أكثر مما تهدي أذهان الطلبة إلى نواحي العبقرية عنده والى مواطن الجمال الفني في شعره والى اثر الظلم الاجتماعي في توجيه عبقريته وفنه وجهة الألم الجامح والهجاء اللاذع.
ويصح في ظني إن قدامي المؤرخين قد صنعوا هذا كله في سيرة ابن الرومي لأن حقيقة التاريخ كانت عندهم مجرد تاريخ الملوك والأمراء والوزراء ومن يدور مدارهم من شعراء وندمان وكتاب وحجاب وجواري وقيان ومغنين، وإنما تكبر عندهم أو تصغر قيمة شاعر من الشعراء أو مفكر من المفكرين على قدر ما يكون نصيبه من شرف الحظوة في مجالس الحاكمين.
ويا لعنة التاريخ لشاعر أو مفكر أبعدته طبيعته أو ظروفه عن قصور الملوك وحاشيات الملوك، كما أبعدت ابن الرومي إذا أبت عليه إن يتصرف مع الملوك تصرف ذوي الملق والزلفى إليهم فابغضوه وأهانوه وأنكروا شانه، فإذا هو محروم مزري محقور، وإذا المؤرخون يعرفون من سيرة بعض المغنين اضعاف ما يعرفون من سيرة شاعر عظيم كابن الرومي.
ولقد كان من اهمال المؤرخين لتفاصيل حياته، اننا لا نزال نجهد في البحث عن حلقات مفقودة من سيرته فلا نجد منها إلا قليلا في شعره فان هؤلاء المؤرخين على كثرة ما رووا من أخبار تطيره وتشاؤمه وشذوذه في التطير والتشاؤم، لم يقولوا لنا كيف عاش ابن الرومي ولا كيف تعلم وتثقف ولا كيف اتفق له إن عاصر الخلفاء، دون إن يتصل بواحد منهم، بمدح أو حظوة أو منادمة أو مجالسة، أو ما يشبه ذلك من الصلات.
ومهما يكن من أمر فان المؤرخين مع اهمالهم شأن هذا الشاعر وظلمهم إياه، فإننا نستطيع باستقصاء أحواله ومراجعة أشعاره ومدارسة جملة الأخبار التي تناثرت في كتب أهل الأدب، من قدامي ومحدثين عن صلاته بالناس وصلات الناس به طوال حياته نستطيع بهذا كله إن نعلم إن ابن الرومي لم يكن كما زعم قدامي المؤرخين وكما يقلدهم بعض مؤرخي الأدب المعاصرين، من أنه ضعيف العقل وانه حسود حقود لئم الطبع، وانه بلغ من التطير والتشاؤم ما يصفون ويبالغون. وإنما نعلم إن ابن الرومي كان إنسانا قوي الإحساس بالحياة قوي الحب لها، قوي الرغبة في الاستمتاع بطيباتها ولكنه لا يستطيع بلوع ما يشتهى منها ثم نعلم، إلى هذا، أنه رجل نال نصيبا وافرا من ألوان المعرفة والثقافة في عصره، لقد كان على علم واسع بفقه اللغة ومفرداتها وآدابها وفقه الشريعة والفلسفة وعلوم الرياضة والفلك، وكان من ذوي الرأي في المذاهب الفلسفية والعقلية المعروفة يومئذ.
ثم نعلم أنه إلى سعة علمه وعبقرية فنه الشعري، كان قليل موارد العيش، وكان يرى من حقه إن ينال منزلته لدى الخلفاء كغيره من أدباء عصره، بل كان عنده من الاعتداد بنفسه بحيث يرى أنه أحق من غيره في إن ينال أعلى منازل الكرامة في بلاط الخلفاء، وإن تحوز يداه أسنى الجوائز والعطايا ليعيش موفروا خلي البال من أمر القوت والجهد في تحصيله
ولكنه لم ينل شيئا من هذا الذي يراه حقا له، لان الخلفاء عرفوا به رجلا لا يصلح لمجالسة الملوك ونيل الحظوة عندهم وإنشاء المدائح بين أيديهم بما كان من ثقته بنفسه حتى لا يرى حاجة للالتزام بما كان يلتزم به الشعراء والمداحون من التملق والتزلف واصطناع أسبابا الحيلة للوصول إلى مجلس الخليفة وانتزاع عطفه وتقديره، وبما كان في طبعه من الصراحة والوضوح بحيث لا يخفي ما في نفسه نقدا أو عتبا أو ملاما إذا ما اقتضى الأمر شيئا من النقد أو العتب أو الملام، وهذا يخالف تقاليد الملوك والأمراء والكبراء.
من أجل هذا كله ظل بعيدا عن قصور الملوك والخلفاء، ولكنه كان على صلة بعدد من الأمراء والوزراء والكتاب والندماء، كأمراء آل طاهر وآل وهب وكنيس بن أبي صاعد وأبي سهل النوبختي وابن ثوابة الكاتب وإسماعيل بن بليل وعلي بن يحيى القديم غير إن هؤلاء جميعا، كيف يقدمون شاعرا جفته قصور الخلفاء، وهم إذا قدموه اشبعوه منه وأذى أكثر مما اعطوه من حقه وقدره.
وقد كان ابن الرومي لا يحتمل المن والأذى من هؤلاء، ولا يحتمل إن يبخسوه حقه وقدره فلا يكاد يمدح أحدهم، وينتقص قدره أو يبخس حقه، حتى يتبع المدح بالعتاب والملام، وقد يتبعه بالهجاء اقسى الهجاء.
كان ابن الرومي محبا للحياة قوي الإحساس فيها فأحس لذعة الحرمان وأبى إن يصانع الملوك كما كانوا يريدون فنبذوه واحتقروه، وتبعهم المؤرخون. وقلد هؤلاء من جاء بعدهم من كتاب التاريخ حتى يومنا هذا فإذا ابن الرومي مظلوم في حياته وفي مماته معا، وليس يكفيه انصافا إن يعرف الناقدون مذاهبه الفنية وكفى. بل الإنصاف الحق لابن الرومي أنه كان في الفكر العربي من أعلام المفكرين والواعين الأحرار الذين اضطهدهم ذوو السلطان لوعيهم مصادر الظلم الاجتماعي ولتعبيرهم عن هذا الظلم بمختلف ألوان التعبير، بل بأروع ما يعرف الحرف العربي كيف يعبر ويصور ويلهم ويوحي للنفوس بالصور تتلاحق ملامحها وتتكامل حتى تكون منها بدعة الفن وبدعة الفكر، وبدعة الحقد الإنساني النبيل الخير الذي ينبع من أقدس ينابيع الحب والخير. لقد حقد فعلا وامتلأ قلبه حقدا شديدا عنيفا غير إن حقده هذا ما كان طبعا لئيما فيه كما يشاء إن يقول المؤرخون، وإنما كان حقدا يصدر عن احساسه القوي بالحياة، وعن حبه العميق للحياة وعن شوقه العارم لكل طيبات الحياة ومشتهياتها، كان يحقد على الحرمان وحده على الذين حرموه طيبات الحياة فقد كان رجلا محروما وكان شعوره بالحرمان عنيفا على نفسه مرهقا شديد الارهاق لعصبه وحسه فقد حرمه نظام مجتمعه الفاسد إن يستمتع بابسط حقوقه الإنسانية فكيف إذن لا ينقم على من يستمتعون بأطايب الحياة دونه ودون الفقراء والمعوزين من سائر فئات الشعب مع أنه كان يرى أولئك أقل منه كفاءة عقل وعلم وانه أعظم منهم في مواهب الفن العبقري.
كيف لا يحقد ابن الرومي على ذوي السلطان وعلى كل مستأثر بأسباب النعمة من رجال الدولة وعلى كل محتكر لموارد الثروة من دون فئات المجتمع كلها؟ كيف يستطيع إن لا يحقد على هؤلاء جميعا حين يرى إلى هذا الحمال الأعمى كما وصفه في هذه القطعة الإنسانية البارعة:
رأيت حمالا حبيس العمى | يعثر في اأكم وفي الوهد |
محتملا ثقلا على رأسه | تضعف عنه قوة الجلد |
بين جمالات وأشباهها | من بشر ناموا على المجد |
وكلهم يصدمه عامدا | أو تائه اللب بلا عمد |
والبائس المسكين مستسلم | أذل للمكروه من عبد |
وما أشتهي ذاك ولكنه | فر من اللؤم إلى الجهد |
فر إلى الحمل على ضعفه | من كلمات المكثر الوغد |
أهذا هو الحسد والحقد ولؤم الطبع في ابن الرومي؟ أترى ما يكون الحق على الظالمين والمحتكرين لؤما، أم تراه يكون نبلا ورحمة وسموا؟. . . فابن الرومي إذا كان ذا طبيعة إنسانية رحيمة وكان ألمه لنفسه ولغيره، أي لحرمانه وحرمان غيره من الجماهير في مجتمعه، وكان إحساسه بالظلم ليس إحساسا ساذجا سلبيا، ولكن كان إحساسا واعيا يعرف الأسباب والمصادر، ويحسن تعليل الظلم وتعليل النوازع النفسية التي تتأثر بالظلم. حفا كان ابن الرومي ساخرا، وذلك لأن سخريته كانت على قدر استخفافه بمن يملكون الجاه والسلطان، أو يملكون الشرف والنعيم، وهم دون غيرهم كفاءة وموهبة وعقلا وأدبا. وعلى قدر ما يرى في مجتمعه ذاك من شخوص تقعد في غير مقاعدها، ومن أوضاع تجري في غير مجاريها، فإذا كل ما في المجتمع مقلوب يثير السخر والتندر فكان ابن الرومي لذلك أقدرن الساخرين وأبرع شاعر أو كاريكاتوري عرفته عصور الأدب العربي.
تطيره
لقد كانت الدولة تجفو هذا الشاعر وتبخسه قدره يضاف إلى هذا أنه كان على شيء كثير من رهافة الحس وسرعة التأثر والانفعال ببواعث الألم، وإن بواعث الألم هذه تكثر في حياته وتكثر في مجتمعه الذي كان يشرف يومئذ على الانحلال الاجتماعي والانهيار الاقتصادي بما كان ينخر في جسم الدولة من علل الفساد والبغي والاستئثار.
ويضاف إلى هذا أيضا إن الشاعر كان يرى إلى كثير من المقربين في مجالس الخلفاء وكبار رجال الدولة تغدق عليهم ألوان الترف والنعم وهو كان يعلم إن أحدا منهم لم يستحق شيئا من هذا بكفاءته وموهبته وإنما استحقه بمجرد إتقانه فن الخداع والزلفى وأساليب المكر والرياء.
ثم يضاف إلى كل ما تقدم إن ابن الرومي لم يكن على بسطة في عيشه بل كان في أكثر أيامه في ضيق العيش محتاجا إلى المعونة، وما كان له من مورد يكفيه الطلب إلى أخوانه أو إلى بعض ممدوحيه سوى موارد ضئيلة جار عليه الناس فاغتصبوه إياها ولم يسعفه أحد بدفع العدوان عنه.
وقد امتحن إلى هذا كله محنته العاطفية إذ فقد أولاده الثلاثة ثم فقد أمه فأخاه الأوحد فزوجه. وكان اثر هذه الفواجع على حسه عنيفا وعلى عصبه الضعيف وطبعه الانفعالي.
وهكذا اجتمعت على ابن الرومي كل هذه الأسباب والعوامل فإذا هو أضعف من إن يطيق احتمالها، وإذا هو ينقلب إنسانا يرى الحياة ظلاما وقتاما وشؤما، ثم إذا كل خاطر من خواطر السوء وكل هاجس من هواجس النحس يتجسم في نظره ويكبر حتى صار معدودا في التاريخ من المتطيرين وحتى ضربت الأمثال بطيرته وتشاؤمه.
ومن هنا يظهر بوضوح إن طيرة ابن الرومي جاءت من خارج نفسه، أي من ظروف حياته كلها، وليست طبعا أصيلا قد خلقت فيه.
وينبغي إن نشير أيضا إلى إن هذه الأخبار نفسها التي يرويها الرواة عن طيرته وتشاؤمه مطعونة بالغلو والمبالغة.
مكانته عند العرب والمستشرقين
لم يلق شاعر من شعراء العربية ما لقيه ابن الرومي من إغفال مقصود أو غير مقصود لفنه ومواهبه في الأدب العربي. . . غير أنه لم يعدم بعض النقاد الذين أنصفوه وتعرضوا لبعض أشعاره. فالمرزباني عقد موازنة طريفة بينه وبين البحتري في الهجاء، وانتصر له. وقال عنه ابن رشيق: أنه أكثر المولدين اختراعا. ومدحه ابن شرف القيرواني بقوله: أنه شجرة الاختراع وثمرة الإبداع، وله في الهجاء ما ليس له في الإطراء، فتح فيه أبوابا، ووصل منه أسبابا، . وأشاد بشعره وصياغته ابن خلكان، وأبو علي القالي، وبديع الزمان الهمذاني، وأبو هلال العسكري، وابن عمار، والثعالبي، وغيرهم.
وحظي ابن الرومي بعناية بعض المستشرقين الكبار ونال إعجابهم. فالمستشرق الألماني يرو كلمن تحدث عنه في الجزء الأول من كتابه المشهور في تاريخ الأدب العربي. والمستشرق الفرنسي أميل درمنجهم اختار له أربع قصائد كأجمل ما في النصوص العربية وترجمها إلى الفرنسية. والأستاذ الفرنسي كليمان هيوار أشاد بشعره وأعجب بجمال تعبيراته وأفكاره.
خلاصة القول في شاعريته
في أي باب من أبواب الشعر كان ابن الرومي يجيد خاصة؟ سؤال لا بد إن يخطر في بالنا في معرض الكلام على صناعته وأسلوبه وأرى إن الكثيرين سيقولون أو قالوا أنه هو باب الهجاء لأنه اشتهر به وشاع أنه مات بسببه، فلنعلم إنهم مخطئون في هذا الحكم لان ابن الرومي كان يجيد في أبواب الشعر كلها على حد سواء، ويعطي قصائده جميعا بمقدار واحد من عنايته وإتقانه. وخذ مثلا أقواله في الحكمة وهي أقل ما اشتهر به تجد له مئات من الأبيات التي تسير مسير الأمثال وتخرج عن عداد تلك الأفكار المطروقة التي يتفيهق بها من يحبون الاشتهار بالبيت الحكيم والمثل السائر، ولو أننا رجعنا إلى أبياته لما ألفينا بينها تفاوتا في الطبقة بين غرض وغرض وباب وباب، وإنما اشتهر بالهجاء لان الهجاء أشهر وأسير، لا لأنه يجيد فيه أكثر من إجادته في المديح أو بالوصف البارع.
وأغرب من هذا الاستواء في طبقة القول أنك تقرأ أشعاره فتحسب إنها نظمت كلها في عمر واحد فلا تدري أيها شعر الشباب وأيها شعر
الكهولة والشيخوخة. إلا ما يندب فيه شبابه ويتبرم بسنه. فقصائده التي نظمت من العشرين إلى الستين طبقة واحدة من هذه الناحية لا تستطيع إن تتحقق فيها مزية سن على سن ولا فترة على فترة. وتعليل ذلك صعب في الشعراء المطبوعين غير ابن الرومي، أما هو فلا صعوبة في تعليل هذا الاستواء في تركيبه والتشابه في روحه ونسجه لأنه ينسج من غزل واحد وبضاعة واحدة، وهي الشعور الجديد أو شعور الطفولة الفتية التي لازمته في حياته من المبدأ إلى النهاية. فلم يتغير فيه إلا القليل بعد ما درس نصيبه من اللغة والعلم واستوفى مادته من الفن والصياغة، وكان الشجرة نضجت مبكرة وبلغت تمامها ورسخت تربتها، فثمرتها اليوم كثمرتها بعد سنوات عشر أو عشرين وثلاثين، ولا عيب في ذلك إلا إن تكون الثمرة شرا لا خير فيه. أما إذا كانت ثمرة جنينة كأطيب الثمر في النظرة والحلاوة فالتبكير إذن أصلح من التأخير والبقاء على طبقة واحدة أحب وأكمل من التغيير.
فالكلمة الأولى والأخيرة في هذا العبقري النادر أنه كان شاعرا في جميع حياته، حيا في جميع شعره وإن الشعر كان لأناس غيره كساء عيد وحلة موسم ولكنه كان له كساء كل يوم وساعة بل كان له جسما لا تكون بغيره حياة. انتهى مقال الدكتور مروة.
تشيعه
يقول الأستاذ العقاد:
كان ابن الرومي شيعيا ومعتزليا. ثم يقول: وكان مذهبه في الاعتزال مذهب القدرية الذين يقولون بالاختيار وينزهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل. ويستشهد الأستاذ العقاد على ذلك بقوله في العباس بن القاشي ويناشده صلة المذهب:
مقالة العدل والتوحيد تجمعنا | دون المضاهين من ثنى ومن جحدا |
ثم يقول العقاد:
فواضح من كلامه هذا أنه معتزلي وانه من أهل العدل والتوحيد وهذا الاسم الذي تسمى به القدرية لأنهم ينسبون العدل إلى الله فلا يقولون بعقوبة العبد على ذنب قضي له وسيق له، ولأنهم يوحدون الله فيقولون إن القرآن من خلقه وليس قديما مضاهيا له في صفتي الوجود والقدم. وقد اختاروا لأنفسهم هذا الاسم ليردوا به على الذين يعتقدون القدر وأولى بان ينسبوا إليه إنما نحن أهل العدل والتوحيد لأننا ننزه الله عن الظلم وعن الشريك.
هذا ما قاله الأستاذ العقاد. ولكن الواقع إن موافقة المعتزلة للشيعة في بعض الأقوال، كالقول بالاختيار وخلق القرآن والحسن والقبح العقليين جعلت بعض الباحثين ينسبون كثيرا من رجال الشيعة إلى الاعتزال حتى لقد قال بعضهم عن السيد المرتضى والصاحب بن عباد أنهما معتزليان وهما من هما في التشيع.
كما قال آخرون عن عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي أنه شيعي، وهو مثل ما قاله الأستاذ العقاد عن ابن الرومي الشيعي، وأين الاعتزال من التشيع، فإذا اتفقا في بعض الأشياء فقد اختلفا في أشياء وأشياء. فان ابن الرومي شيعي، ولا يمكن إن يكون الشيعي معتزليا ولا المعتزلي شيعيا.
وإذا قال ابن الرومي بالعدل والتوحيد والاختيار وخلق القرآن فلان الشيعة والمعتزلة متفقان في هذا على حين أنهما مختلفتان في غير هذا.
ابن الرومي في هجائه
وقال الدكتور محمد مصطفى هدارة:
لم ينل شاعر من إعراض مؤرخي الأدب مثل ما لقيه ابن الرومي، بسبب كثرة خصوماته في عصره وإفراطه في الهجاء حتى صدق ما قاله فيه أحد معاصريه إن لسانه أطول من عقله. والمتصفح لديوان ابن الرومي سواء ما طبع منه، أو الجزء الذي لا يزال مخطوطا، يرى الهجاء غالبا على كل ما عداه من فنون الشعر فيما عدا المديح، حتى ليرسخ في النفس إن هذا الشاعر عدو للناس والمجتمع،
بعيد عن الاتزان وضبط النفس، وهما سمة الإنسان والعاقل، قريب من معاداة الإنسانية بمعناها العام، بل لقد يحس كذلك أنه اتخذ الهجاء صناعة بحكم علله النفسية وما يشعر به من نقص وحقد وحسد وغيرة إزاء الناس والمجتمع. وكثيرا ما كان الهجاؤون يعانون مثل هذه العلل والنقائص التي تدفعهم إلى التعويض بسلاطة اللسان، والتهجم على الأعراض، وتخويف من عداهم من البشر المسالمين.
ولكننا ننفي ذلك كله عن ابن الرومي من واقع أخباره وأشعاره، ونرى أنه في كل أهاجيه برغم كثرتها وفحشها وسلاطتها كان الضحية المعتدى عليه، وإن هجاءه كان سلاحا للدفاع عن النفس، في عصر لا يبر الضعفاء، ولا يرحم المساكين، وإن هذا السلاح لم يكن ابن الرومي يشرعه إلا في حالة الاضطرار والاستفزاز. كان ابن الرومي بطبعه مصافيا للناس يألفهم ويألفونه، ويبرهم ويبرونه، ولكنه كان فقيرا يكتسب بشعره، شديد الحساسية في احتفال بكرامة نفسه وكرامة شعره على السواء، وكان فيمن صادفهم ابن الرومي في حياته الغني الذي يريد استعباده بماله، والعابث الذي يلمح فيه مواطن الضعف فيلح عليها بعبثه، والغبي الذي يجهل قيمة شعره، وأمثال هؤلاء كانوا يستفزون ابن الرومي فيضطر إلى هجائهم، ويحركون فيه طبعه الحاد، أو طبعه المقاتل الذي لا يستسلم، ولا يستكين لمهاجمة.
وقد يغفر بعض الباحثين هجاء ابن الرومي للكثرة الهائلة من شعراء عصره وكتابه وعلمائه من أمثال البحتري، والناجم، والناشئ، والمبرد، ونفطويه، والأخفش، وقد يتسامحون في هجاء ابن الرومي للمغنين والمغنيات في أيامه، ولكنهم يقفون من ابن الرومي موقف التشكك والاتهام بالنسبة لهجائه من سبق له مدحهم من ذوي المناصب العامة، هؤلاء الذين كان يتوجه إليهم بمديحه، ليستعين بجوائزهم على مواصلة الحياة، فهل كان ابن الرومي إنسانا غير سوي الطبيعة، مرائيا منافقا عديم الوفاء؟ وأيهما كان أصدق: مديحه السابق أم هجاؤه اللاحق؟ وإذا كان مديحه نفاقا في سبيل لقمة الخبز، فما جدواه من وراء هجاء ذوي المناصب، وبعضهم كان لا يزال في منصبه؟ هل نجد في شخصية ابن الرومي تهورا واندفاعا في سبيل الهجاء، بحيث ينكب عن ذكر العواقب جانبا؟
إن مصاحبتنا لشعر ابن الرومي تجعلنا نؤكد أنه لا يبتدر خصومه بالهجاء، بل يظل يصبر عليهم حتى لا تبقى للصبر بقية، وهو حذر جدا في علاقته بذوي السلطان، لأنه شديد الإحساس بعوزه وحاجته إلى التكسب بشعره، ومحال إن يقطع معين رزقه لاندفاع أو تهور، بل ما أعجبه حين
يصف لنا حذره من ذوي السلطان، ويضع بنفسه حدودا لهجائه في قوله:
لا أقذع السلطان في أيامه | خوفا لسطوته ومر عقابه |
وإذا الزمان أصابه بصروفه | حاذرت رجعته ووشك مثابه |
واعد لؤما إن أهم بعضه | إذ فلت الأيام من أنيابه |
تالله أهجو من هجاه زمانه | حرمت مواثبتيه عند وثابه |
فليعلم الرؤساء إني راهب | للشر، والمرهوب من أسبابه |
طب بأحكام الهجاء، مبصر | أهل السفاه بزيفه وصوابه |
حرم الهجاء على امرئ غير امرئ | وقع الهجاء عليه من إضرابه |
أو طالب قوتا حماه قادر | ظلما حقوق طعامه وشرابه |
ما احكم هذا الدستور الذي وضعه ابن الرومي لهجائه وما أشد صرامته، أنه لا يهجو أصحاب السلطان وهم في أوجهم، خوفا من سطوتهم وعقابهم، فإذا خان الزمان أحدهم عف ابن الرومي عن هجائه خوفا من عودته إلى السلطة مرة أخرى. ولكن هذه العفة لا تقوم على أساس الخوف وحده، بل على أساس من كريم الخلق، فمن اللؤم هجاء إنسان تعرض لمحنة. وكم من الشعراء كانوا ينهشون ممدوحيهم السابقين بمجرد تجردهم من السلطة، وكان البحتري مشهورا بذلك، فقد هجا نحو أربعين من ممدوحيه السابقين بعد تجردهم من السلطان. وابن الرومي يطمئن الرؤساء من ناحيته، فهو يرهب الشر، وهو خبير بأحكام الهجاء: متى يجوز ومتى لا يجوز، وهو يقصر جواز الهجاء على موضعين: الرد على من يهاجيه من أقرانه، وردع الظالمين الذين يمنعون الفقير حق ما يقتات به. فإذا كان ابن الرومي قد خرج على دستور الهجاء الذي وضعه، فليس من سبب لهذا الخروج إلا إن يكون اضطرارا يستفز الشاعر لهذا الهجاء.
وأول من يلقانا من أصحاب المناصب، ممن هجاهم ابن الرومي بعد مدح، إبراهيم بن المدبر الكاتب الذي شغل عدة مناصب هامة، كان من بينها منصب وزير المعتمد. ويترجم له ياقوت فيقول عنه إبراهيم بن محمد بن عبيد الله ابن المدبر، أبو إسحاق الكاتب، الأديب الفاضل، الشاعر الجواد المترسل، صاحب النظم الرائق والنثر الفائق، تولى الولايات الجليلة، ووزر للمعتمد، توفي 279 ه وهو يتقلد ديوان الضياع للمعتضد ببغداد وقد مدحه ابن الرومي بمناسبة هروبه من سجن الزنج سنة 257 ه، ولكن يبدو إن ابن المدبر لم يكن كريما مع ابن الرومي بحيث يمنحه جائزة سخية على مديحه، بل لعله بحكم شاعريته خاض في نقد شعر ابن الرومي، ولهذين السببين استحق الهجاء، ويطالبه ابن الرومي في بعض هجائه برد قصائد مديحه فيه، ولو ممزقة، يقول:
أردد على قراطيسي ممزقة | كيما تكون رؤسا للدساتيج |
فان ذلك أدنى من تشاغلها | بحفظ مدحك يا علج العلاليج |
ومن أصحاب المناصب الذين سبق لابن الرومي إن مدحهم ثم عاد فهجاهم، أحمد بن محمد الطائي الذي كان واليا على الكوفة سنة 269 ه، وظل في منصبه حتى قبض عليه سنة 275 ه كما يذكر المسعودي والطبري في أحداث تلك السنة. وقد هجاه ابن الرومي لسببين يزكيان خروجه عن دستوره في الهجاء، أما السبب الأول فهو مماطلة الطائي في تحقيق وعد قطعه على نفسه بإجراء عطاء على ابن الرومي، والسبب الآخر اختطافه ابن أحد الكتاب واتخاذه رهينة بسبب خوفه من القتل في أثناء وزارة ابن بلبل في واسط، أي حوالي سنة 273 ه، كما نعلم من تتبع حياة ابن بلبل. يقول ابن الرومي في هجائه للطائي مطمئنا وهو في حمى ابن بلبل:
علج ترقى رتبة فرتبة | ولم يكن أهلا لهاتيك الرتب |
فزل من تلك المراقي زلة | أصبح منها مشفيا على العطب |
وهكذا، كل ارتقاء في العلا | قريب عهد بارتقاء في الكرب |
وعلى الرغم من صلة ابن الرومي القوية بأبي الصقر إسماعيل بن بلبل الذي تقلب في عدة مناصب رئيسية، فكان رئيسا لديوان الضياع في سامراء سنة 255 ه، وكان وزيرا في أيام الموفق، وعلى الرغم من مدائح ابن الرومي المطولة فيه في مناسبات مختلفة، وعلى مدى سنوات كثيرة إلا أنه ناله بهجائه، وكان السبب الواضح في ذلك إغفال ابن بلبل المتعمد لابن الرومي، ومنعه ما يستحق من جوائز على مديحه، فهو يقول له:
ما بال شعري لم توزن مثوبته | وقد قضت منه أوزان وأوزان |
ويستخدم ابن الرومي قبل إن يتحول تماما إلى هجاء ابن بلبل أسلوبا طريفا في الهجاء يبدؤه بمعنى صريح غاية في الصراحة، وهو إن مديحه لابن بلبل ليس نابعا من محبة شخصية أو إعجاب به، ولكن للحصول على عطائه فحسب، يقول:
أظنك خبرت إني امرؤ | أبر الرجال بشعري احتسابا |
وذلك أحسن ما في الظنون | إذا ما أخ بأخيه استرابا |
ول غيرك السائمي ما أرى | تشعبت للظن فيه شعابا |
فقلت: غبي كسا جهله | نواظره دون شمسي ضبابا |
وران على قلبه رينه | فليس يريه صوابي صوابا |
أذلك؟ أو قلت: كان امرءا | رأى الجود ذنبا عظيما، فتابا؟ |
هفا هفوة بالندى، ثم قال | أنبت إلى الله فيمن أنابا؟ |
أذلك؟ أو قلت: بل لم يزل | أخا البخل إلا عدات كذابا |
مريغ ثناء بلا نائل | يمني أماني تلقى سرابا |
إلى كل ذاك تميل النفوس | أخطأ ظن بها أم أصابا |
وابن الرومي في هذه القصيدة يستخدم أسلوبا غير مباشر في الهجاء، يقوم على الظن والافتراض الذي قد يكون مرده إلى الخطأ، ولكنه بعد كل ظن يقول له: أذلك وكأنه يريد إن ينتزع منه اعترافا بصحة كل ما افترضه فيه من سوء الظن. وقد ألح ابن الرومي على ادعاء إسماعيل بن بلبل نسبا عربيا في شيبان، وكان ادعاء العروبة بين ذوي الأصول الأعجمية كثيرا منذ القرن الثاني الهجري. يقول ابن الرومي فيه:
عجبت من معشر بعقوتنا | باتوا نبيطا، وأصبحوا عربا |
مثل أبي الصقر، إن فيه وفي | دعواه شيبان آية عجبا |
بيناه علجا على جبلته | إذ مسه الكيمياء، فانقلبا |
عربه جده السعيد كما | حول زرنيخ جده ذهبا |
يا عربيا، آباؤه نبط | يا نبعة كان أصلها غربا |
كم لك من والد ووالدة | لو غرسا الشوك أثمر العنبا |
بل لو يهزان هزة نثرت | من رأس هذا وهذه رطبا |
لم يعرفا خيمة، ولا وتدا | ولا عمودا لها، ولا طنبا |
ولم يكن ابن الرومي في هجائه إسماعيل بن بلبل متجنيا، بل إن هذا الرجل قد أذله بحيث جعله يعري مشاعره بصورة كاملة، فإذا بنا إمام إنسان مظلوم قهره الظلم، يبيع عصارة فكره ولا يجد من يشتري، بل إن الممدوحين يحاولون إذلاله وإساءة معاملته، فهو يقول لإسماعيل بن بلبل هذا:
كم نسام الأذى، كانا كلاب | كم، إلى كم يكون هذا العقاب |
كلما جئت قاصدا لسلام | ردني عن لقائك البواب |
ما كذا يفعل الكرام، ولا تر | ضي بهذا في مثلي الآداب |
أنا حر، وأنت من سادة الأحرار | أهل الحجا المصاص اللباب |
وقبيح بعد الطلاقة والبشر | بذي المجد نبوة واحتجاب |
وجميل من ابن الرومي إن يذكر ممدوحه بأنه حر مثله، وليس عبدا يقرع، أو كلبا يطرد. وهذا الموقف اللاأخلاقي من جانب إسماعيل بن بلبل جعل هجاء ابن الرومي ذا نفحة إنسانية، على الرغم من تعبيره عن ذاتيته فهو يقول:
حرمت في سني وفي ميعتي | قراي من دنيا تضيفتها |
لهفي على الدنيا، وهل لهفة | تنصف منها إن تلهفتها؟ |
كم آهة قد تأوهتها | فيها، ومن أف تأففتها |
أغدو، ولا حال تسفعتها | فيها، ولا حال تردفتها قبحا لها، |
قبحا، على إنها | أقبح شيء حين كشفتها |
تعسفتني إن رأتني امرءا | لم ترني قط تعسفتها |
كددت النفس، من بعد ما | رفهتها قدما وعففتها |
لا طالبا رزقا سوى مسكة | ولو تعدت ذاك عنفتها |
طالبت ما يمسكها مجملا | فطفت في الأرض وطوفتها |
وناكد الجد، فمنيتها | وماطل الحظ، فسوفتها |
ما أشد إحساس ابن الرومي بعذابه في هذه الدنيا التي لم يرد منها إلا ما يمسك عليه حياته، ومع ذلك يأبى الحظ إن يماطله عن طريق أولئك الممدوحين الذين لا يثيبونه على شعره الرائع، وليس غير هذا الشعر وسيلة لاكتساب الرزق الشحيح، الذي لا يحصل عليه إلا بعد كد ومعاناة.
ونستفيد مما تقدم، ومن كثير غيره إن ابن الرومي كان مظلوما في هجائه لممدوحيه السابقين، فقد كان موقفهم منه مخزيا متعفنا وقد صدق العقاد حين قال: وأنت تقلب ديوان ابن الرومي فتقرأ فيه عشر قصائد في الشكوى والتذكير والاستبطاء والإلحاح والإنذار والهجاء، إلى جانب قصيدة واحدة في المدح.
ويعدد العقاد مواقف الممدوحين المخزية من ابن الرومي، فإسماعيل بن بلبل يسيء فهم مديحه الرائع فيه ويظنه هجاه، ومحمد بن عبد الله بن طاهر يهجو شعر ابن الرومي:
مدحت أبا العباس اطلب رفده | فخيبني من رفده، وهجا شعري |
ويكتب قصيدة في عتاب أبي سهل النوبختي، فيراها ملقاة في جانب
الدار، وقد خطط في ظهرها بالمداد، والرياح تتلاعب بها، ولهذا يقول له:
رقعة من معاتب لك ظلت | ولها في ذراك مثوى مهان |
سطر العابثون فيها أساطير | عفت متنها، فما يستهان |
خط ولدانكم أفانين فيها | أو رجال كأنهم ولدان |
وقبيح يجوز كل قبيح | وقعة من معاتب لا تصان |
وكان ابن الرومي يشعر باستبعاد الممدوحين له، فهم يمنون عليه إن قبلوه في مجالسهم، واحضروه موائدهم، ويفرضون عليه وفاء العبد للسيد، والصنيعة لولي النعمة، ويظنون إنهم كلفوه بالعيش الرغيد، والظل الظليل، يقول ابن الرومي في ذلك:
إذا امتاحهم أكلة عبدوه | تعبيد رب لمربوبه |
يخالون إنهم بلغو | ه بالقوت أفضل مطلوبه |
وأنهم حرسوا نفسه | به من غوائل مرهوبه |
يذيل مضيفهم ضيفه | كملبوسه أو كمركوبه |
ولهذا هجا ابن الرومي ممدوحيه السابقين، وكان يروي إنهم غافلون عن شعره:
ما خمدت ناري، ولكنها | ألفت قلوبا نارها خامدة |
أو هم جاهلون لا يفهمون:
ما بلغت بي الخطوب رتبة من | تفهم عنه الكلاب والقرده |
وما أنا المنطق البهائم والطير | سليمان قاهر المرده |
وقد بالغ العقاد في الدفاع عن موقف ابن الرومي من هجاء ممدوحيه فجعلهم كلهم أو أكثرهم لصوصا، لا ينقضي على أحدهم في المنصب أشهر أو سنوات حتى يعمر بيته بالمنهوب والمسلوب من أرزاق الرعية الضعفاء، وليست القضية بهذا التعميم، كما إنها ليست قضية لصوصية الممدوحين بل قضية إنسانيتهم المضيعة إزاء هذا الشاعر الذي ذوب عصارة فكره في تمجيدهم، ولم يقبض منهم إلا على هواء، فعاش مضطهدا كسيرا، ومات مهضوما مظلوما.
من شعره
نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها | ثم انثنت عنه فكاد يهيم |
الموت إن نظرت وإن هي أعرضت | وقع السهام ونزعهن اليم |
وله في وصف السيف وهو نهاية في معناه:
يشيعه قلب رواء وصارم | صقيل بعيد عهده بالصياقل |
تشيم بروق الموت في صفحاته | وفي حده مصداق تلك المخايل |
وقد أكثر الشعراء في ذكر الأوطان ومحبتها والشوق إليها فجاء ابن الرومي مع قرب عهده فذكر الوطن وبين عن العلة التي لها يحب وزاد عليهم أجمعين وجمع ما فرقوه في أبيات من قصيدة يخاطب بها سليمان بن عبد الله بن طاهر وقد أريد على بيع منزله فقال:
ولي وطن آليت إن لا أبيعه | وإن لا أرى غيري له الدهر مالكا |
عهدت به شرخ الشباب ونعمة | كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا |
وقد ألفته النفس حتى كأنه | لها جسدان غاب غودر هالكا |
وحبب أوطان الرجال إليهم | مأرب قضاها الشباب هنالكا |
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم | عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا |
وله في معناه:
بلد صحبت به الشبيبة والصبا | ولبست ثوب العيش وهو جديد |
فإذا تمثل في الضمير رأيته | وعليه أغصان الشباب تميد |
وله وسمعه البحتري فاستجاده:
يقتر عيسى على نفسه | وليس بباق ولا خالد |
ولو كان يسطيع من بخله | تنفس من منخر واحد |
وله من قصيدته الطويلة:
لما تؤذن الدنيا به من صروفها | يكون بكاء الطفل ساعة يولد |
وإلا فما يبكيه منها وإنها | لافسح مما كان فيه وارغد |
وله في إبراهيم بن المدبر وكان رد عليه قصيدة مدحه بها:
رددت علي مدحي بعد مطل | وقد دنست ملبسه الجديدا |
وقلت امدح به من شئت غيري | ومن ذا يقبل المدح الرديدا |
ولا سيما وقد عبقت فيه | مخازيك اللواتي لن تبيدا |
وهل للحي في أثواب ميت | لبوس بعد ما امتلأت صديدا |
وأورد له في شرح رسالة ابن زيدون في الشماتة وقد بالغ فيها:
لا زال يومك عبرة لغدك | وبكت لشجو عين ذي حسدك |
فلئن بكيت فطالما بكيت | بك همة لجات إلى سندك |
أو تسجد الأيام ما سجدت | إلا ليوم فت في عضدك |
يا نعمة ولت غضارتها | ما كان أقبح حسنها بيدك |
فلقد بدت بردا على كبدي | لما غدت حرا على كبدك |
ورأيت نعمى الله زائدة | لما استبان النقص في عددك |
لم يبقى لي مما برى جسدي | إلا بقايا الروح في جسدك |
ومن شعره الذي يدل على قوله بالعدل وعدم الجبر قوله في ذكر مساوي الحقد من قصيدة:
يا ضارب المثل المزخرف مطريا | للحقد لم تقدح بزند واري |
شبهت نفسك والألى يولونها | آلاءهم بالأرض والعمار |
وزعمت فيك طبيعة أرضية | يا سابق التقرير بالاقرار |
فينا وفيك طبيعة أرضية | تهوي بنا أبدا لشر قرار |
هبطت بآدم قبلنا وبزوجه | من جنة الفردوس أفضل دار |
فتعوضا الدنيا الدنية كاسمها | من تلكم الجنات والإنهار |
بئست لعمر الله تلك طبيعة | حرمت أبانا قرب أكرم جار |
واستأسرت ضعفي بنيه بعده | فهم لها اسرى بغير اسار |
لكنها ماسورة مقسورة | مقهورة السلطان في الأحرار |
فجسومهم من اجلها تهوي بهم | ونفوسهم تسمو سمو النار |
عرفوا لروح الله فيهم فضل ما | قد أثرت من صالح الآثار |
فتنزهوا وتعظموا وتكرموا | عن لؤم طبع الطين والأحجار |
لا ترض بالمثل الذي مثلته | مثلا ففيه مقالة للزاري |
الأرض في أفعالها مضطرة | والحي فيه تصرف المختار |
فمتى جريت على طباعك مثلها | فكان طرفك بعد من فخار |
أخرجت من باب المشيئة مثلما | خرجت فأنت على الطبيعة جاري |
انى تكون كذا وأنت مخير | متصرف في النقض والامرار |
أين انصراف الحي في أنحائه | وحويله فيما سوى المقدار |
أين اختيار مخير حسناته | إن كنت لست تقول بالإجبار |
شهد اتفاق الناس طرا في الهوى | وتفاوت الأبرار والفجار |
أن الجميع على طباع واحد | وبما يرون تفاضل الأطوار |
قاد الهوى الفجار فانقادوا له | وأبت عليه مقادة الأبرار |
لولا صنوف الاختيار لأعنقوا | لهوى كما اتسقت جمال قطار |
ورأيتهم مثل النجوم فإنها | متتابعات كلها لمدار |
متيممات سمت وجه واحد | ولها مطامع حجة ومجاري |
وله في أمير المؤمنين علي عليه السلام من قصيدة:
يا هند لم أعشق ومثلي لا يرى | عشق النساء ديانة وتحرجا |
لكن حبي للوصي مخيم | في الصدر يسرح في الفؤاد تولجا |
فهو السراج المستنير ومن به | سبب النجاة من العذاب لمن نجا |
وإذا تركت له المحبة لم أجد | يوم القيامة من ذنوبي مخرجا |
قل لي أأترك مستقيم طريقه | جهلا واتبع الطريق الأعوجا |
وأراه كالتبر المصفى جوهرا | وأرى سواه لناقديه مبهرجا |
ومحله من كل فضل بين | عال محل الشمس أو بدر الدجى |
قال النبي له مقالا لم يكن | يوم الغدير لسامعيه ممجمجا |
من كنت مولاه فذا مولى له | مثلي فأصبح بالفخار متوجا |
وكذاك إذ منع البتول جماعة | خطبوا وأكرمه بها إذ زوجا |
وقال في أمير المؤمنين علي (ع):
تراب أبي تراب كحل عيني | أما رمدت جلوت به قذاها |
تلذ لي الملامة في هواه | لذكراه وأستحلي أذاها |
قال من قصيدة يرثي بها يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) حين ثار على الظلم وفساد الحكم أيام العباسيين:
إمامك فانظر أي نهجيك تنهج | طريقان شتى مستقيم وأعوج |
ألا أيهذا الناس طال ضريركم | بال رسول الله فاخشوا أو ارتجوا |
أ كل أوان للنبي محمد | قتيل زكي بالدماء مضرج |
تبيعون فيه الدين شر أئمة | فلله دين الله، قد كان يمرج |
بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم | لبلواكم عما قليل مفرج |
أ ما فيهم راع لحق نبيه | ولا خائف من ربه يتحرج |
لقد عمهوا ما انزل الله فيكم | كان كتاب الله فنهم محجحج |
ألا خاب من أنساه منكم نصيبه | متاع من الدنيا قليل وزبرج |
أ بعد المكنى بالحسين شهيدكم | تضيء مصابيح السماء فتسرج |
لنا وعلينا لا عليه ولا له | تسحسح أسراب الدموع وتنشج |
وكيف نبكي فائزا عند ربه | له في جنان الخلد عيش مخرفج |
فان لا يكن حيا لدينا فإنه | لدى الله حي في الجنان مزوج |
وكنا نرجيه لكشف عماية | بأمثاله أمثالها تتبلج |
فساهمنا ذو العرش في ابن نبيه | ففاز به، والله أعلى وأفلج |
أ يحيى العلى لهفي لذكراك لهفة | يباشر مكواها الفؤاد فينضج |
لمن تستجد الأرض بعدك زينة | فتصبح في أثوابها تتبرج |
سلام وريحان وروح ورحمة | عليك وممدود من الظل سجج |
ولا برح القاع الذي أنت جاره | يرف عليه الأقحوان المفلج |
ويا أسفي إن لا ترد تحية | سوى ارج من طيب رمسك يأرج |
ألا إنما ناح الحمائم بعد ما | ثويت وكانت قبل ذلك تهزج |
ألا أيها المستبشرون بيومه | أظلت عليكم غمة لا تفرج |
أكلكم أمسى اطمأن مهاده | بأن رسول الله في القبر مزعج |
فلا تشتموا وليخسأ المرء منكم | بوجه كان اللون منه اليرندج |
فلو شهد الهيجا بقلب أبيكم | غداة التقى الجمعان والخيل تمعج |
لأعطى يد العاني أو ارتد هاربا | كما ارتد بالقاع الظليم المهيج |
ولكنه ما زال يغشى بنحره | شبا الحرب حتى قال ذو الجهل:أهوج |
وحاش له من تلكم، غير أنه | أبى خطة الأمر الذي هو اسحج |
وأين به عن ذاك؟ لا أين، أنه | إليه بعرقيه الزكيين محرج |
كأني به كالليث يحمي عرينه | وأشباله لا يزدهيه المهجهج |
كدأب علي في المواطن قبله | أبي حسن، والغصن من حيث يخرج |
كأني أراه والرماح تنوشه | شوارع كالأشطان تدلى وتخلج |
كأني أراه إذ هوى عن جواده | وعفر بالترب الجبين المشجج |
فحب به جسما إلى الأرض إذ هوى | وحب بها روحا إلى الله تعرجا |
أأرديتهم يحيى ولم يطو أيطل | طرادا ولم يدبر من الخيل منسج |
تأتت لكم فيه منى السوء هينة | وذاك لكم بالغي أغرى وألهج |
تمدون في طغيانكم وضلالكم | ويستدرج المغرور منكم فيدرج |
اجنوا بني العباس من شنآنكم | وأوكوا على ما في العياب وأشرجوا |
وخلوا ولاة السوء منكم وغيهم | فأحربهم إن يغرقوا حيث لججوا |
نظار لكم إن يرجع الحق راجع | إلى أهله يوما، فتشجوا كما شجوا |
على حين لا عذرى لمتذريكم | ولا لكم من حجة الله مخرج |
فلا تلقحوا الآن الضغائن بينكم | وبينهم إن اللواقح تنتج |
غررتم لئن صدقتم إن حالة | تدوم لكم والدهر لونان اخرج |
لعل لهم في منطوى الغيب ثائرا | سيسمو لكم، والصبح في الليل مولج |
أ في الحق إن يمسوا خماصا وأنتم | يكاد أخوكم بطنة يتبعج |
وتمشون مختالين في حجراتكم | ثقال الخطى أكفالكم تترجرج |
وليدهم بادي الضوى ووليدكم | من الريف ريان العظام خدلج |
بنفسي الالى كظتهم حسراتكم | فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا |
وعيرتموهم بالسواد، ولم يزل | من العرب إلا محاض أخضر أدعج |
ولكنكم زرق يزين وجوهكم | بني الروم! ألوان من الروم نعج |
أبى الله إلا إن يطيبوا وتخبثوا | وإن يسبقوا بالصالحات ويفلجوا |
وان كنتم منهم وكان أبوكم | أباهم فان الصفو بالرفق يمزج |
وقال في أهل أبيت:
إن يوال الدهر أعداء لكم | فلهم فيه كمين قد كمن |
خلعوا فيه عذار المعتدي | وغدوا بين اعتراض وارن |
فاصبروا يهلكهم الله لكم | مثل ما أهلك اذواء اليمن |
قرب النصر فلا تستبطئوا | قرب النصر يقينا غير ظن |
ومن التقصير صوني مهجتي | فعل من أضحى إلى الدنيا ركن |
لا دمي يسفك في نصرتكم | لا ولا عرضي فيكم يمتهن |
غير إني باذل نفسي وإن | حقن الله دمي فيما حقن |
ليت إني غرض من دونكم | ذاك أو درع يقيكم ومجن |
أ تلقى بجبيني من رمى | وبنحري وبصدري من طعن |
إن مبتاع الرضي من ربه | فيكم بالنفس لا يخشى الغبن |
وله في رثاء شبابه:
أبين ضلوعي جمرة تتوقد | على ما مضى أم حسرة تتجدد |
خليلي ما بعد الشباب رزية | يجم لها ماء الشؤون ويعتد |
فلا تلحيا للجلد يبكي فربما | تفطر عن عين من الماء جلمد |
شباب الفتى مجلودة وعزاؤه | فكيف وأنى بعده يتجلد |
وفقد الشباب الموت يوجد طعمه | صراحا، وطعم الموت بالموت يفقد |
رزئت شبابي عودة بعد بدأة | وهن الرزايا بادئات وعود |
سلبت سواد العارضين وقلبه | بياضهما المحمود إذ أنا امرد |
وبدلت من ذاك البياض وحسنه | بياضا ذميما لا يزال يسود |
لشتان ما بين البياضين معجب | أنيق ومشنوء إلى العين أنكد |
وكنت جلاء للعيون من القذى | فقد جعلت تقذى بشيبي وترمد |
هي الأعين النجل الذي كنت تشتكي | مواقعها في القلب والرأس اسود |
فما لك تأسى الآن لما رأيتها | وقد جعلت مرمى سواك تعمد |
تشكى إذا ما أقصدتك سهامها | وتأسى إذا نكبن عنك وتكمد |
كذلك تلك النبل من وقعت به | ومن صرفت عنه من القوم مقصد |
إذ عدلت عنا وجدنا عدولها | كموقعها في القلب بل هو اجحد |
تنكب عنا مرة فكأنما | منكبها عنا إلينا مسدد |
كفى حزنا إن الشباب معجل | قصير الليالي والمشيب مخلد |
إذا حل جارى المرء شاو حياته | إلى إن يضم المرء والشيب ملحد |
أرى الدهر أجرى ليله ونهاره | بعدل فلا هذا ولا ذاك سرمد |
وجار على ليل الشباب فضامه | نهار مشيب سرمد ليس ينفد |
وعزاك عن ليل الشباب معاشر | فقالوا نهار الشيب أهدى وارشد |
وكان نهار المرء أهدى لسعيه | ولكن ظل الليل أندى وابرد |
أأيام لهوي هل مواضيك عود | ولهل لشباب ضل بالأمس منشد |
أقول وقد شابت شواتي وقوست | قناتي وأضحت كدنتي تتحدد |
ولذت أحاديثي الرجال وأعرضت | سليمى وريا عن حديثي ومهرد |
وبدل أعجاب الغواني تعجبا | فهن روان يعتبرن وصدد |
لما تؤذن الدنيا به من صروفها | يكون بكاء الطفل ساعة يولد |
وإلا فما يبكيه منها وإنها | لافسح مما كان فيه وارغد |
وللنفس أحوال تظل كأنها | تشاهد فيها كل غيب سيشهد |
وما لي عزاء عن شبابي علمته | سوى إنني من بعده لا أخلد |
وان مشيبي واعد بلحاقه | وإن قال قوم أنه يتوعد |
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 8- ص: 250